أميركا الماضي والحاضر: فصامُ شخصية أم التباسٌ ثقافي تاريخي؟
"باسم الله العلي، آمين. نحن الموقعين أدناه. من الرعايا المخلصين لمولانا صاحب الجلالة الملك جيمس المعظم. بفضل الله ونعمته. سيد بريطانيا العظمى وفرنسا وإيرلندا. حامي حمى الدين والذائد عن حياض الوطن. بعد أن قمنا برحلتنا لتأسيس أول مستعمرة في الأجزاء الشمالية من فرجينيا. تمجيداً لاسمه تعالى. وترويجاً للدين المسيحي. وتعظيماً لملكنا ولبلادنا. نتعهد بموجب هذه الميثاق بالتكافل والتضامن.
أمام الله، وأمام بعضنا البعض، بأن نتفق ونتحد معاً في كيانٍ سياسي مدني واحد. وصولا إلى درجة أعلى من تنظيم الذات والمحافظة عليها وتحقيق ما ورد ذكره من أهداف. وأن نسعى بموجب هذا الميثاق إلى وضع، وصياغة، وتنفيذ، قوانين عدل ومساواة، وتشريعات وأنظمة ودساتير ومناصب، من وقتٍ إلى آخر، حسبما تقتضيه الضرورة والمصلحة. خدمة للخير العام في المستعمرة، وتحقيقا له، والتعهد بتطبيق ما ورد فيها من أحكام والامتثال لها".
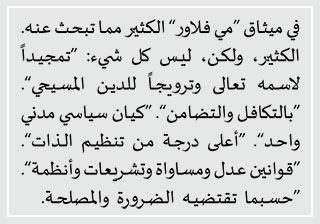
سُمّيَت الكلمات أعلاه "ميثاق مي فلاور". وقّعَ عليها واحدٌ وأربعون رجلاً، ولم يُسمح بذلك للنساء.. تم التوقيع على ظهر السفينة "مي فلاور / Mayflower" في الحادي عشر من نوفمبر / تشرين الثاني عام 1620 وهي على الشاطئ. ثم نزل الركاب منها إلى اليابسة. يومها، ظهرت أميركا، سياسياً، إلى الوجود.
تبحث عن تفسير لظاهرةٍ معقدة اسمها الولايات المتحدة الأميركية، وتبحث على وجه الخصوص عما يساعدك على فهم المنظومة السياسية الأميركية في هذا العصر، فتجد في ميثاق "مي فلاور" الكثير مما تبحث عنه. الكثير، ولكن، ليس كل شيء: "تمجيداً لاسمه تعالى وترويجاً للدين المسيحي". "بالتكافل والتضامن". "كيان سياسي مدني واحد". "أعلى درجة من تنظيم الذات". "قوانين عدل ومساواة وتشريعات وأنظمة". "حسبما تقتضيه الضرورة والمصلحة. خدمةً للخير العام في المستعمرة". هذه عباراتٌ (مفتاحية). ورغم الخوف من الوقوع في فخ التبسيط، لا يمكنك إلا أن تربطها بكثير مما جرى ويجري في أميركا من تلك اللحظة إلى هذا اليوم.
لَحقَ بالسفينة سفنٌ أخرى عديدة. تكاثرَ سكانُ المستعمرة. جاءت أجيالٌ تتلوها أجيال.
وكما هو حال الطبيعة البشرية، انقسم الناس في درجة تركيزهم على القيم الواردة في تلك العبارات المفتاحية، وفي طريقة تفسيرهم لها. لكن هذه التجربة الضخمة حملت في بذورها التباساً أساسياً لايزال يصاحبها حتى الآن. بل يمكن القول إن هذا الالتباس هو مصدر الأسئلة والتحديات الكبرى التي تواجه أميركا، والعالم معها، على كل صعيد.
فما بين معنى ومتطلبات الالتزام الديني، والدلالة العملية للتكافل والتضامن، وطرق تفسير القوانين والأنظمة، ودلالات الالتزام بقيم الحرية والعدل والمساواة، ومداخل تحقيق مصالح (المستعمرة)، وتحديد طبيعة العلاقة مع الآخر. ظهر تشابكٌ معقّد أدّى منذ، تلك الأيام المبكرة، إلى الأحداث الكبرى التي شهدها التاريخ الأميركي.
تمت إبادة شعوب كاملة من الهنود الحمر (الآخرين). حدث هذا عملياً لتحقيق "مصالح المستعمرة". لكنه كان عند البعض نظرياً تمجيداً للرب وتنفيذاً لأوامره في تخليص الدنيا من الرعاع والهمج، حتى لا يبقى فيها سوى (المؤمنون).
ثم جاءت حرب الاستقلال عن بريطانيا (الأُخرى) التزاماً من البعض بقيمة الحرية وتحقيقاً لها. لكن البعض الآخر رفض هذه الفكرة لأن فيها خروجاً على ملك بريطانيا "حامي حمى الدين والذائد عن حياض الوطن".
رغم هذا. رسّخَ حلم الاستقلال والصراع من أجله قيمة الحرية في الثقافة الأميركية بشكلٍ فريد في التاريخ البشري. بل دفع الأميركان لاستخراج جذور لها من المصادر القديمة للثقافة الرومانية واليونانية. فعندما دافع أندرو هاملتون، الذي كان من أشهر محامي "المستعمرات البريطانية" في أميركا، عن جون بيتر زنجر، الصحفي الذي ألقى حاكمُ مستعمرة نيويورك البريطاني القبض عليه بتهمة إثارة الفتنة بعد نقده لسياساته، استعاد المحامي مقولة بروتس التي خاطب بها بطانة يوليوس قيصر والمقربين منه "أيها الرومان.. عليكم التأمل بما تنصرفون إليه من أعمال. وتذكروا دائماً وأبداً أنكم كنتم عونا لقيصر في صياغة القيود والأغلال التي سيكبلكم بها ذات يوم". ورمى بهذه المقولة في وجه القضاة.
أثناء حرب الاستقلال كانت أول أغنيةٍ وطنية أميركية هي "أغنية الحرية" التي يقول مطلعُها "تعالوا أيها الأميركيون الشجعان نضم أيدينا معاً جميعاً. أيقظوا قلوبكم الجريئة لنداء الحرية الجميل. لن تَقمع أيةُ أفعال تسلطية دعوتكم العادلة. أو تلطخ بالعار اسم أميركا".
أثناء تلك الحرب أيضاً. ألقى باتريك هنري، أحد الثوار، والذي أصبح فيما بعد أول حاكم لولاية فرجينيا، خطبةً ناريةً في الولاية ختمها بقوله "لا علم لي بالسبيل الذي قد يرغب الآخرون اختياره. أما بالنسبة لي، فأعطني حريتي أو أعطني الموت".
من يومها، أصبح شعار ولاية نيوهامبشر الأميركية "عش حراً أو اختر الموت". لهذا، ربما، نقشَ توماس جيفرسون، الذي كتب مسودة إعلان الاستقلال وأصبح لاحقاً رئيساً للولايات المتحدة، الكلمات التالية بخط يده على بلاطة ضريحه: "هنا يرقد توماس جيفرسون صاحب إعلان الاستقلال. ومُشرّع قانون فرجينيا حول حرية الأديان. ومؤسس جامعة فرجينيا".
تحقق حلم الاستقلال عام 1776، بعد أكثر من مائةٍ وخمسين عاما على التوقيع على ميثاق "مي فلاور". وتم إدراج قيمه في الدستور الأميركي، ثم في تعديلاته، بشكلٍ أو بآخر.
مع هذه العملية، تحقق حلم الحرية.
لكن الالتباس في الثقافة الأميركية لم يبقَ قائماً فقط، بل صارَ أكبر.
بدأت تجارة (الرقيق) من أفريقيا قبل الاستقلال واستمرت بعده. (المصلحة) و(الآخر) من جهة، و(الحرية) من جهةٍ أخرى. لم يكن الدين بعيداً عن الموضوع عند البعض. مرةً أخرى، رأى هؤلاء أن استعباد الملايين يهدف إلى نقلهم من الهمجية إلى الحضارة! عارضَ العبوديةَ بعضُ دعاة الحرية مثل بنجامين فرانكلين وألكسندر هاملتون، لكن الأغلبية كانت للرأي الآخر.
كان لابد من الانتظار لأكثر من ثمانين عاماً.
ثم جاءت الحرب الأهلية. الجنوب (المتدين)، الذي يرفض إعطاء (الحرية) للعبيد (الآخرين)، في مواجهة الشمال (الليبرالي / الآخر) الذي يريد ذلك. اختلف الأميركان بشكل جذري هذه المرة حول ما يحقق (المصلحة). لم يكن هناك مفرٌ من اللجوء إلى السلاح والعنف. اهتزَّ "الكيان السياسي المدني الواحد" بضع سنوات. لكنه سرعان ما عاد إلى التماسك بعد ذلك. انتهى الرق، رسمياً على الأقل. لكن مسيرة تحقيق المساواة والعدالة كانت طويلة.
مضت عقودٌ وعقود، كانت خلالها أميركا تتعايش مع الالتباس وما ينتج عنه داخلياً، ثم جاءت الحرب العالمية الأولى. في الأعوام الثلاثة الأولى من الحرب، حاولت أميركا البقاء على الحياد والحفاظ على عزلتها التقليدية عن العالم. لكن الزمن كان قد تغير. أغرقَت الغواصات الألمانية بعض السفن التجارية الأميركية، فتحركت غريزة ميثاق "مي فلاور" التي تقضي بالتصرف "حسبما تقتضيه الضرورة والمصلحة، خدمةً للخير العام في المستعمرة". دخلت أميركا الحرب. ثم دخلت بعد ذلك إلى العالم. دخلت بالتباسها المُعقّد، وأصبح التعامل مع هذا الالتباس عالمياً قصةً أخرى.
خرجت أميركا من عزلتها التقليدية مع الحرب الأولى، وبدأت تدخل في العالم. بدأت العملية على استحياء، ثم تأكدت مع الحرب العالمية الثانية. أنعش اقتصادُ الحرب أميركا الخارجة من فترة الكساد الكبير الصعبة، فأدركت مراكزُ القوى السياسية والاقتصادية فيها أن على هذا الكوكب عالَماً خارج الولايات المتحدة، وأن التعامل مع هذا العالم يمكن أن يحقق الكثير من الأهداف والمصالح.
رغم هذا. كان التحول في الموقف من العالم مقتصراً على أوساط النخبة. أما الثقافة السائدة في أوساط الشعب الأميركي، فقد ظل يغلب عليها الجهل بالعالم والزهد في التعامل معه، إلا على سبيل السياحة.
أمسكت مراكز القوى السياسية والاقتصادية بالفرصة السانحة، فأخذت على عاتقها تحديد أهداف السياسة الخارجية الأميركية. تمحورت تلك الأهداف، علنياً، حول أمرين: حماية وخدمة المصالح الأميركية، وتأكيد (القيم) التاريخية لأميركا، وخاصة منها ما يتعلق بالحرية وحقوق الإنسان. للمفارقة، تولت مراكز القوى تلك أيضا مهمة تعريف (مصالح) أميركا، فاختلط حابل القيم بنابل المصالح. وسرعان ما أصبح توظيف القيم لخدمة المصالح سمةً غالبة في السياسة الخارجية الأميركية. المفارقة هنا أن العالم خارج أميركا أدرك تدريجياً تلك الحقيقة، لكن الغالبية العظمى من الشعب الأميركي ظلت تجهلها من قريب أو بعيد. لم يحصل ذلك لأنهم شعب من الملائكة. وإنما، ببساطة، نتيجةَ الثقافة السائدة المُغرقة في (محليتها) من جهة، وبسبب تركيبة النظام السياسي الأميركي من جهة ثانية.
خذ شريحةً عشوائية من الشعب الأميركي وحاول أن تتعرف على بعض ما تؤمن به. ستجد شعباً يعشق الحرية كقيمة، ويقدّرُ الديمقراطية كنظام سياسي، ويُؤمن بحقوق الإنسان بشكلٍ عام. ستجد أيضاً شعباً تجهل غالبيته ماي جري في العالم، ليس فقط خارج أميركا، وإنما خارج دائرة الاهتمام المحلية الضيقة. وهي دائرةٌ يغلب أن يقف قطرها عند حدود الحي أو المدينة على أبعد تقدير. إضافةً إلى ذلك، ستجد شعباً زاهداً في عملية المشاركة السياسية، إن لم يشعر بحاجةٍ ملحةٍ لها. شعباً يحرص بشكل كبير على أمنه واستقراره ورفاهيته المادية، وتبهره الكاريزما الشخصية، ويعشق الإثارة، ويحب التغيير. وأخيراً، شعباً ذاكرتهُ قصيرة المدى إلى أبعد الدرجات.
فَهِمَ السياسي الأميركي تركيبة الثقافة السياسية للمواطن الأمريكي، فأتقن العزف على وَتر القيم في مجال السياسة الخارجية، بغضّ النظر عن العلاقة الحقيقية بين تلك القيم وهذه السياسة.
اسمع سياسياً أميركياً يتحدث عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان أمام حشد من مواطنيه وستجد نفسك مجبراً على أن تصدق ما يقول، أقلّهُ من درجة التفاعل النفسي والعملي التي تظهر في مثل هذه اللقاءات مع تلك المقولات. وهي درجةٌ لا يمكن أن يدركها من لم يعايش المجتمع الأميركي عملياً في مثل هذه المناسبات.
لا يعني هذا بأن كل سياسي أميركي هو منافق بالطبيعة. ولا أن كل ممارسات الساسة في أميركا تتمحور حول تلك الصفة. فهذا اختزالٌ وتعميم يتناقض مع الحقيقة والواقع في بلدٍ تتعايش فيه أقصى التناقضات في كل مجال، حتى في مجال السياسة، حيث يمكن أن تجد من يصدمك بدرجة التزامه بالمبادئ والقيم التي يتحدث عنها الجميع، سواء فيما يتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية. لكن هؤلاء لا يمثلون الأكثرية بطبيعة الحال. أما فيما وراء تلك الشريحة، فإن جزءاً لا يستهان به من الساسة يقعون ضحية اللبس التاريخي الذي ذكرناه بين المصالح والمبادئ في المنظومة الثقافية والسياسية الأميركية. ومن هؤلاء خَرَجت، وستخرج على الدوام، الشريحة التي تفرز سياساتها الخارجية المآسي التي سببتها أميركا في العالم، ولم تنجُ هي من آثارها في الداخل.
فبعد الحرب العالمية الثانية، أخذ هؤلاء أميركا إلى الحرب الكورية دفاعا عن (الحرية) وتحقيقاً لـ (المصلحة) في مواجهة (خطر) الشيوعية. فَقَدت البلاد في الحرب أكثر من خمسين ألف قتيل. رغم هذا، لم تمضِ سنوات إلا وقال جون كينيدي في حفل تنصيبه رئيساً: "فلتدرك كل دولة، سواء تمنّت الخير أو الشرّ لنا، أننا على استعداد لدفع أي ثمن، وتحمل أي عبء، ومواجهة أي صعوبات، ومساندة أي صديق، ومجابهة أي عدو، في سبيل ضمان استمرار ونجاح الحرية". بعدها، غرقت أميركا في حرب فيتنام وخسرت أكثر من خمسة وخمسين ألف قتيل. ومعهم قُتل مليون مقاتل وأربعة ملايين مدني من فيتنام!

جون كينيدي، الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة الأميركية
كانت الضربة قوية. فانسحبت أميركا من الدخول الصاخب في العالم عقداً ونيف. اكتفى صانعوا القرار السياسي بالتدخل الاستخباراتي الهادئ البعيد عن الضجيج.
مرَ الزمن، وتغيرت الظروف، غلبت الذاكرة قصيرة المدى، ونسيت أميركا ما حصل. وبعد قرابة عقدين من تصريح كينيدي، تحدّث رونالد ريغان عن أميركا بوصفها "النموذج الأصلي للحرية ومنارة الأمل لمن لا يتمتعون الآن بالحرية".
ولأكثر من عقد، عادت أميركا للدخول في العالم بقوة. فمن "هزيمة" الاتحاد السوفياتي وتفكيك المنظومة الشيوعية على مستوى الدول والأفكار، إلى طرد صدام حسين من الكويت ومحاصرته في العراق، صار ممكناً جداً تحقيق مصالح استراتيجية كبرى في لبوسٍ من المبادئ: نشر الديمقراطية والحرية، حق الشعوب في تحديد مصيرها، هزيمة محاور الشر وامبراطورياته ورموزه في العالم، وهلم جراً. وظهرت التجليات النظرية لهذا الواقع في خطابات نظرية كان من أشهرها مقولات فوكوياما وهنتينغتون المعروفة.
رغم كل هذا، غابت، لوهلةٍ، في حسابات الجمهوريين درجة اهتمام الأميركي بوضعه المادي كعاملٍ مرجحٍ في كل انتخابات، فظهر بيل كلينتون بمقولته المشهورة مخاطباً الرئيس جورج بوش الأب، بشكلٍ غير مباشر، بقوله" إنه الاقتصاد أيها الغبي". كان هذا رداً على ظنٍ ترسخ في ذهن بوش وحملته الانتخابية لولايته الثانية يقضي بأن انتصاره "الكبير" في حرب الخليج الثانية على صدام، وتحقيقه "المصلحة" في الخارج، سيكون وحده كفيلاً بإعادة انتخابه. فوق هذا، غفل الجمهوريون أيضاً عن حب الأميركان للكاريزما. وفي مواجهة بوش العجوز الباهت الشخصية، كان كلينتون شاباً مفعماً بالحيوية وواعداً بشيء جديد.
اختطف كلينتون، غير المعروف والقادم من ولاية آركنساس الهامشية، البيت الأبيض. ومع أن تركيزه كان على السياسات الداخلية، إلا أنه لم يُغفل الإشارة إلى مسألة "القيم" في السياسة الخارجية. فقال في خطاب تنصيبه عام 1993 إنّ "آمالنا وقلوبنا وأيادينا، كلها مع أولئك الذين يقيمون الديمقراطية والحرية في كل قارة. إنّ قضيتهم هي قضية أميركا".
لهذا، كان التدخل، في الغالبية العظمى من الحالات، من بنما إلى غرانادا ومن صربيا إلى كوسوفو، باسم الحرية. لكن الاعتقاد كان سائداً في أوساط الإدارة، والمنظومة السياسية بشكلٍ عام، أن تحقيق الحرية في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية خصوصاً لا علاقة له بتحقيق "المصلحة". من هنا، جاء التدخل تجميلياً أو مضبوطاً، وفي معظم الأحيان، جامعاً بين الأمرين.
لكن نهاية التسعينيات كانت لحظة نادرة في رحلة الحياة الأميركية. فلأسباب تاريخية ثقافية واقتصادية وديموغرافية، ومع طفرة تكنولوجيا المعلومات وصعود الإعلام الموسوم بشكلٍ عام على أنه "ليبرالي"، باتت تلك لحظةً فريدة، تقاربت فيها كثير من قيم اليمين واليسار الأساسية في أميركا، واختفت فيها، لدرجة معينة، الفوارق الرئيسة بين برامج الحزبين الديمقراطي والجمهوري فيما يتعلق بجملة من القضايا الأساسية في الواقع الأميركي، حتى بات بعض الإعلاميين والمفكرين والنشطاء يتندرون، وقتَها، قائلين بأن لدينا، في أميركا، حزباً واحداً باسمين.
فمن جهة، تبنى الحزب الديمقراطي، بقيادة كلينتون، مجموعة من المبادئ التي تُنسب إلى الجمهوريين، مثل عمليات الخصخصة والسماح بالاندماج الاحتكاري الضخم وتخفيف دور الحكومة، بل وإزالة بعض برامج الضمانات الاجتماعية التي اشتهر بها الديمقراطيون.
في المقابل، كانت قياداتٌ جمهورية تتحدث عن ضرورة إعادة النظر في موقف الجمهوريين السلبي تاريخياً من الضمانات الاجتماعية، وعن ضرورة إخراج ما يسمى بنموذج (الرأسمالي الرحيم اجتماعياً) إلى الوجود.
أما في أوساط المجتمع الأميركي فقد كانت تلك الفترة من القرن الماضي ذروة تشكيل عقدٍ اجتماعي جديد غير مكتوب، من تقاليده زيادة احترام الأقليات والاعتراف بدورها في البلاد، بل والقيام بمراجعات تاريخية أكاديمية وإعلامية وحقوقية لما واجهته تلك الأقليات في الماضي من مظالم واضطهاد.
كما عمَّ في أميركا بشكل كاسح مصطلح (Political Correctness / الصوابية السياسية)، وشاع استخدامه في كل مجال لتأكيد وجود تقاليد وحدود وأعراف تحكمُ، بشكل صارمٍ أحياناً، كيفية تناول الحساسيات الإثنية والعرقية والدينية وتلك التي تتعلق بجنس الإنسان (Gender)، وتُحدد أطر التعامل مع تلك الحساسيات في الخطاب السياسي والإعلامي والأكاديمي والفني والأدبي والثقافي العام داخل أميركا.
لم تصبح أميركا بلداً مثالياً فيما يتعلق بقضايا توزيع الثروة وقضايا العدل الاجتماعي المتعلقة بأنظمة التعليم والضمان الصحي وأجور العمال، وحتى المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة. وبقيت هيمنة المؤسسات الاحتكارية الكبرى، ومراكز القوى المعروفة بالمجمع العسكري الصناعي. أكثر من هذا، كان معروفاً أن "المؤسسة" بكل ما تحويه من دلالات يحملها المصطلح الأميركي The Establishment لاتزال صاحبة النفوذ الأكبر في البلاد نهاية المطاف.
كان يتحدث ويكتب ويحاضر عن هذه القضايا مفكرون من أمثال نعوم تشومسكي وإدوارد سعيد وهوارد زن وغيرهم، حين أشار هؤلاء إلى المفاصل الضعيفة في المنظومة السياسية التي تسمح لمجموعات مركزية بالتحكم في صناعة القرار من خلال قوة المال بالذات.
غير أن الرخاء النسبي الذي كانت تشهده الولايات المتحدة في تلك الفترة جعل رؤية هؤلاء صرخةً في واد. ثم إن المواطن الأميركي، الذي ينظر إلى عالمه ويحكم عليه من خلال بضعة مؤشرات بسيطة، لم يمتلك القدرة على التقاط الرسائل المعقدة التي تكمن في مثل تلك الرؤى المتقدمة.
لكن أخطر ما فاتت رؤيته على ذلك المواطن، وعلى كثيرين غيره داخل أميركا وخارجها، تمثلَ في التخطيط الاستراتيجي الذي كان يقوم به تيارٌ اشتُهر فيما بعد بالتيار اليميني المحافظ. وإن كان الأصح النظر إليه على أنه تيارٌ أكثر تطرفاً داخل التيار المحافظ نفسه.
ففي خضم الحراك الذي عاشته أميركا في التسعينيات، كانت مجموعات هذا اليمين المتطرف تنظر إلى ما يجري على أنه يمثل ضياع بوصلة أميركا الحقيقية، وكانت تشعر باضطراد أن البلاد فقدت رؤيةً استراتيجية مركزية تعيد لها هويتها الأصيلة داخلياً، وموقعها القيادي المهيمن في الساحة العالمية.
كانت هذه المجموعات تعتبر ما يجري في أميركا عملية تفكيك للبنى الأساسية للمنظومة الفلسفية التي كانت السبب وراء "عَظَمة" الولايات المتحدة محلياً وفي الساحة الدولية. وكانت تنظر إلى التطورات التي تحدثنا عنها أعلاه على أنها الدليل الأكيد على دخول البلاد مرحلة ميوعةٍ سياسية وثقافية واهتراء فوضوي عشوائي لا يبدو له ضابط.
تداخلت في المسألة بطبيعة الحال المصالحُ الشخصية ببعض القناعات الأيديولوجية المُغرِقة في لاهوتيتها، وكانت الخلاصة تتمثل لديهم في إعادة رسم تلك الرؤية الاستراتيجية المركزية التي تعيد أميركا إلى ما كانت عليه.
بدأت المجموعات المذكورة رحلة بحث طويلة في أدبيات بعض المفكرين والفلاسفة المحافظين الأميركان التاريخيين مثل ريتشارد ويفر وفرانك ميير وفريدريك هايك ورسل كيرك وجيمس بيرنهام.
وشيئا فشيئاً، ومن خلال قراءة انتقائية لأدبيات المحافظين التاريخية، تشكلت لدى مجموعات المحافظين الجدد تلك الرؤية المركزية الاستراتيجية التي يجب أن تعيد أميركا إلى ما يرون أنه المسار الصحيح.
ظهرت الرؤية في وثائق عديدة كان أشهرها وأكثرها شمولاً "مشروع القرن الأميركي الجديد" الذي صدر في يونيو/ حزيران 1997 وتحته توقيع شخصيات معبرة، منها ديك تشيني ودونالد رامسفيلد وبول وولفويتز وزلماي خليل زاده.
رغم هذا، بقي المحافظون الجدد في انتظار لحظة تاريخية تسمح لهم بتنزيل رؤيتهم تلك على أرض الواقع، وجاءت تلك اللحظة ساعةَ انهيار برجي مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر/أيلول 2001.
تغير الوضع بشكل معقّد بعد ذلك اليوم المشهود من الزمان. أصبح اللبسُ الحقيقي، والتلبيس المقصود، بين المصلحة والمبادئ أكبر من ذي قبل. خاصةً في مجال العلاقة بالآخر. وصار ممكناً، بدرجةٍ غير مسبوقة في التاريخ الأميركي، استغلالُ طبيعة التركيبة الثقافية للشعب الأميركي لصياغة السياسة الخارجية كما يريد السياسي. أضف إلى هذا العامل الديني / الأيديولوجي الذي برز بقوة كمكونٍ من مكونات الفكر السياسي في أميركا. عادت هنا، لدى بعض أفراد الشريحة المحافظة الحاكمة مقولة "تمجيداً لاسمه تعالى وترويجاً للدين المسيحي" فتحدث بوش عن حروب صليبية جديدة، وكان قبلها أكد غير ذي مرة على شعوره بأنه ينفذ مهمةً أو إرادةً إلهية. اختلط هذا، مرةً أخرى، مع "ما تقتضيه الضرورة والمصلحة. خدمة للخير العام في المستعمرة".
ساعدَ على هذا قبلَها بشهور أن الأميركان، المولعين بالكاريزما الشخصية، لم يهضموا جدّيةَ وثقافةَ المرشح الديمقراطي آل غور. فاختاروا بدلاً منه راعي البقر المغامر الآتي من ولاية تكساس الجنوبية جورج (دبليو) بوش الابن. وسنرى تأثير هذا العامل مرةً ثالثة ورابعة مع أوباما وترامب كما رأيناه قبلها مع كلينتون.
لم تشفع لـ (غور) صفاتهُ المتميزة، رغم أن وجودها لدى البعض هو الذي يصنع كل شيءٍ جيد في أميركا. ولم يؤثر في قرارهم تاريخُ بوش المليء بالفشل والإحباط والتفاهات، ولاشخصيتهُ المفعمة بالسطحية والسذاجة إلى درجة الغباء في بعض الأحيان.
كان يمكن لسنواته التي قضاها في البيت الأبيض أن تكون فترة رئاسة لإدارةٍ جمهوريةٍ روتينيةٍ أخرى. حتى في وجود صقور المحافظين من حوله عن اليمين وعن الشمال. فقد أصبح الرجل بسرعةٍ فائقة مادةً دسمة للفكاهة والتندر في البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من جلوسه خلف المكتب البيضاوي. غير أن التاريخ كان يحمل في أحشائه مولوداً سيظهر إلى الحياة بعد تلك الأشهر القليلة، وفي الحادي عشر من سبتمبر على وجه التحديد.
أصابت ضربة سبتمبر أمريكا وحلمها في الصميم، فصدّقت أن رجلاً مثل بوش الابن سيخرجها من صدمتها الكبرى، وربما يمكن القول إنها لم تكن، بثقافتها السائدة، تملكُ خياراً آخر.

من أحداث الحادي عشر من أيلول، الولايات المتحدة الأميركية
لكل هذا، أفلح المحافظون الجدد في أن يحشروا التاريخ البشري بأسره في كبسولة اسمها 11 سبتمبر/ أيلول. وجرت محاولة ربط غير مسبوقة لكل فعاليات الحياة الإنسانية بجانب من جوانب ذلك الحدث. ورغم أن هذا لم يحصل في تاريخ البشرية من قبل، فإن أميركا انساقت، ومعها العالم بأسره، في ذلك المسار.
أدرك العالم خارج أميركا أبعاد ما يجري على المستوى الاستراتيجي، فتشكل ما يمكن القول إنه موقف دولي يمتزج فيه الحذر بالمجاراة والترقب.
الحذر من باب إدراك الخطورة الحقيقية للتوجهات الاستراتيجية للإدارة الأميركية، والمجاراة من باب إدراك حساسية مواجهة الوحش الهائج والقوي في الوقت نفسه، والترقب من باب انتظار المتغيرات التي يمكن أن تسمح بمزيد من المبادرة لتغيير هذا الواقع الصعب.
أما الداخل الأميركي فرغم وضعه المعقد ثقافياً واجتماعياً وأمنياً بعد أحداث سبتمبر، فقد بدأ يدرك أن الإدارة، ومن ورائها مؤسسات اليمين المحافظ، باتت تهدم تدريجياً كل عناصر ذلك العقد الاجتماعي الذي تحدثنا عنه، وأنها صارت تمارس عملية خرق منظمة لكل الأعراف والقواعد والقوانين التي ترى النخبة المثقفة بوعيها، وغالبية الشعب في أعماقه، أنها تشكل الرصيد المعرفي والفلسفي الذي يحفظ تماسك أميركا، خاصة في ظل التغييرات الديمغرافية الهائلة التي حصلت فيها، وما نتج وينتج عنها من تغيير ثقافي واجتماعي لا تنفع في التعامل معه أسس ومبادئ نظرية وفلسفية مستوردة انتقائياً من أحشاء بعض كتب التاريخ.
من هنا، بدأت رحلة المراجعات داخل أميركا ثقافياً وإعلامياً وحقوقياً على استحياء بعد الأشهر الأولى من احتلال العراق، ثم تصاعدت بشكل منتظم. في تقديم أحد الكتب الناقدة لإدارة بوش، قال ناشر الكتاب "لا يشك أحد في أن الجمهوريين أنذال كاذبون فاسدون وغير مؤهلين للحكم، لكنهم دون شك يعرفون كيف يصلون إلى الناخب".
تمثلت صدقية هذه المقولة في إعادة انتخاب الرئيس بوش الابن عام 2004 رغم كل ما فعلته إدارته خلال السنوات السابقة. ذلك أن تفاصيل سياساته ونتائجها لم تظهر بشكلٍ جلي إلا بعد إعادة انتخابه. وتدريجياً، امتلأت منابر الإعلام الأمريكي بالقصص.
على سبيل المثال، لم تنفجر فضيحة سجن أبو غريب في العراق رسمياً إلا في مطلع عام 2004 بعد انتخاب بوش بأشهر قليلة، علماً أن هذه الفضيحة هزت بشكلٍ كبيرٍ ونادر الرأي العام الأميركي.
وبالإضافة إلى شن حرب على العراق بدلائل مزيفة، والتعامل مع العالم بتكبرٍ وعنجهية، وجعله أقل أمناً وسلاماً، وممارسة التعذيب للسجناء بشكل غير قانوني، وخرق المعاهدات والاتفاقات الدولية، وحكم أمريكا بطريقة التخويف، وتقليص مساحة الحريات فيها وفي العالم أجمع، وتغليب مصالح عصابة النفط والأسلحة على مصالح الناس في الولايات المتحدة وخارجها، والحكم على الدول والشعوب والأحداث والمواقف برؤيةٍ يمينية أيديولوجية خرقاء، ظهرت خلال الولاية الثانية من حكم بوش الابن حقائق التالية أصابت الرأي العام الأمريكي بالذهول، كان منها على سبيل المثال:
الحكم على ستيفن غريلز، نائب وزير الداخلية، بالسجن 10 شهور عام 2007 للمشاركة في فضيحة جاك أبراموف الناشط الجمهوري الذي كان من المفترض فيه أنه يعمل كرجل (لوبي) لمصلحة بعض القبائل الهندية الأصلية، ثم وجدت الحكومة أنه اختلس وابتز منها قرابة 85 مليون دولار مع مجموعة من الشركاء. وقد شملت الفضيحة أيضا أحد كبار موظفي الوزارة روجر ستيلويل، وروبرت كوغلن رئيس قسم مكافحة الإجرام في وزارة العدل، وديفيد سافافيان رئيس الموظفين في إدارة الخدمة العامة.
واستقالت جولي ماكدونالد، نائب مساعد وزير الداخلية، عام 2007 بعدما وجد تحقيق داخلي أنها أطلعت بعض العاملين في جماعات الضغط (اللوبي) على وثائق حكومية.
واستقال ليستر كراوفورد، المفوض العام لوكالة الغذاء والأدوية، فجأة عام 2005 بعد أن تم الكشف بأنه يملك أسهم في شركات من المفترض به أن يضع أو يتابع القوانين التي تنظم عملها.
أما كلود آلين، مساعد الرئيس للسياسات الداخلية، فقد استقال من البيت الأبيض فجأة عام 2006 قائلا إنه يريد إمضاء وقت أكبر مع عائلته، ثم تبين أنه تم القبض عليه وإدانته بتهمة السرقة من متاجر (تارغِت) بمبالغ تتجاوز 500 دولار!
ثم ذهب برايان دويل، نائب الناطق باسم وزارة الأمن القومي، إلى السجن عام 2005 في فضيحة جنسية تتعلق بالأطفال! ومن وزارة الأمن القومي نفسها استقال عام 2005 فرانك فيغاروا، الذي كان رئيس العمليات الخاصة بمكافحة استغلال الأطفال، لكنه استقال بعد الكشف عن تحرشه الفاحش جنسيا بفتاة قاصر في أحد الأسواق التجارية.
وهناك جون كورسمو، رئيس مجلس إدارة الإسكان الفيدرالي، الذي استقال بعد اعترافه بأنه دعا رجال بنوك من المفترض فيه أنه يشرف على ضبط عملها إلى حفلة جمع تبرعات لأحد رفاقه من المرشحين للكونغرس.
وبعده استقال كارل تروسكوت، رئيس إدارة الكحول والتبغ والأسلحة، عام 2006 بعد اعترافه بأنه أمر بعض موظفي إدارته بمساعدة ابن اخته لإنتاج فيلم مدرسي كان على الولد القيام به كواجب مدرسي.
أما كين توملينسون، الذي كان مدير شركة الإذاعة القومية، فقد استقال عام 2005 بعد أن تبين أنه يدير عمليات مقامرة على سباقات الفروسية من مكتبه، إضافة إلى أنه كان يعين أصدقاءه من ذوي التوجه اليميني في الشركة التي كان يرى أنها منحازة لليبراليين.
ثم استقال المدير التنفيذي للـ (سي آي إيه) بعد أن اعترف بأنه مذنب في فضيحة ديوك كونينغهام المتعلقة برشوات في الكونغرس.
واستقالت جانيت رينكويست، ابنة قاضي المحكمة العليا المشهور الراحل ويليام رينكويست، من منصبها كمفتش في إدارة الصحة والخدمات الإنسانية بعد تدخلها لتأخير عملية تدقيق محاسبي لمنشأة لشركة بوينغ في فلوريدا، بناء على طلب جيب بوش، شقيق الرئيس جورج بوش الابن. وهو ما أجبر أيضا رئيس القوى الجوية على الاستقالة.
أما فيليب كوني، رئيس موظفي مجلس البيت الأبيض للحفاظ على البيئة، فقد استقال بعد أن تبين أنه اطلع على تقارير تؤكد وجود الاحتباس الحراري، لكنه خرج ليصرح للصحافيين بعد ذلك بأن كل شيء على ما يرام. وقد اتفقت شركة إكسون موبيل النفطية العملاقة مع الرجل لتوظفه لديها كي لا يبقى بدون عمل! وفي نفس الاتجاه، استقال الناطق باسم وكالة ناسا الفضائية، بعد أن أخذ على عاتقه منع موظفي حماية البيئة الحكوميين من الكلام عن الموضوع قدر ما أمكن.
ثم استقال شين تونيس، الذي كان المسؤول الطبي في إدارة التأمين الصحي للكبار، بعدما تبين أنه زوَّر أوراقاً تتعلق بتأهيله العلمي. علماً أن الإدارة احتفظت به لشهور في منصبه بعد ظهور الحقيقة.
وكان بيرني كيريك على بعد خطوة من أن يصبح وزير الأمن القومي، أي المسؤول الأول عن الأمن في البلاد، قبل أن تتم إدانته في اللحظة الأخيرة بالفساد وقبول الرشاوى!
أما القضية المشهورة فتتعلق باستقالة سكوت ليبي، رئيس هيئة موظفي نائب الرئيس ديك تشيني، الذي أدين في أربع تهم تتعلق بتسريب المعلومات والكذب قبل أن يغادر البيت الأبيض.
أخيراً وليس آخراً، استقال صديق الرئيس بوش ووزير العدل، ألبرتو غوانزاليس، بعدما تبين أنه كذب على الكونغرس بشأن طرد موظفين وقضاة من الوزارة بسبب آرائهم التي لا تتفق أيديولوجيا مع آرائه وآراء الرئيس والإدارة.
قد يُظهر هذا الاستعراض تعقيد المنظومة الأمريكية، بل وربما يبين أن شريحة من الفاسدين تنال جزاءها بشكلٍ أو بآخر نهايةَ المطاف في تلك المنظومة. لكنه يُظهر على وجه التأكيد جانباً من أسباب رد الفعل العنيف في أميركا، والذي أدى إلى (انقلابها) مائة وثمانين درجة لتنتخب باراك أوباما عام 2008. تَرافقَ هذا، بطبيعة الحال، مع الزلزال الاقتصادي الهائل الذي أصاب البلاد تدريجياً في آخر عامين من إدارة بوش الابن الثانية، والتي اتضح للجميع دورها في التهرب من التعامل مع الأزمة، إن لم يكن التسبب فيها.
فوق هذا، كان قد تكرّس في الوعي الأميركي، على مدى عقود، حبٌ يكاد يكون مجنوناً لـ "التجربة". تحبُّ أميركا أن تُجرّب، حتى لو كان في التجربة نوعٌ من المجازفة. فثقافة هذه البلاد معجونةٌ بمعاني المغامرة والبحث عن الفُرص والركض وراء الجديد. كما أنها مسكونةٌ بهاجس حلمٍ بشري ليس له حدود، تمّ تعريفه بشكلٍ معبّر في كلمتين هما (الحلم الأمريكي).
لكن أميركا لا تصبر كثيراً على تجربةٍ واحدة. وكلما كانت التجربة قاسيةً أصبحت رغبتُها ملحّةً في أن تنتقل من النقيض إلى النقيض. فالتجربة القاسية والواقع الصعب يمثلان حقيقةٌ يحتاج تجاوزها إلى حلمٍ جديد.
أرادت أميركا (البيضاء) دائماً أن تكون البلد الحلم الذي وضعَ دستورهُ رجالٌ بيض مثل جورج واشنطن وتوماس جيفرسون. ففتحت أبوابها وحدودها لكل من يبحث عن حلم، ويريد أن يعمل لتحقيقه. كان غالبية (الحالمين) في بداية الأمر من البيض. فتقاطرَ إليها الناس من إيرلندا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من دول أوروبا. لكن العالم بدأ يتغير. فازدادت أعداد الحالمين في مناطق أخرى. وبدأ هؤلاء يأتون إلى البلاد، لكنهم كانوا هذه المرة من جميع الألوان والأعراق والأجناس والأديان.
وبما أن الحلم كان كبيراً وصارخاً وحاضراً في الثقافة والتاريخ، وفي كل الأدبيات النظرية، لم يكن ثمة بدٌ من أن يمارس الحلم حتى أولئك الذين أُحضرهم البيضُ ليكونوا عبيداً من أفريقيا على وجه التحديد.
كانت الرحلة طويلةً ومليئةً بالألم والتضحية والعذاب. لكن الحلم بقي حياً لدى هؤلاء، ولدى الأقليات الأخرى، مع وجود رجالٍ من أمثال كليفتون ديبيري الذي أصبح أول مرشح أسود لمنصب نائب الرئيس في عام 1964، وقبله بكثير فيكتوريا وودهول، التي كانت بدورها أول امرأة مرشحة (بيضاء) لمنصب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة عام 1872. عرف هؤلاء طبعاً أنه لم تكن لديهم أيّ فرصةٌ للنجاح في ذلك الزمن. لكنها كانت خطوةً ضروريةً على طريق تأكيد إمكانية تحقيق الحلم، وعلى حتمية الاستمرار في ممارسته والعمل من أجله.
بقي الحلم حياً وحاضراً في الأذهان والقلوب، وبقيت شعلته ملتهبةً مع مالكوم إكس، ثم وصلت إلى ذروتها حين تحدث مارتن لوثر كينغ حرفياً منذ أكثر من خمسة عقود عن الحلم المنتظر، وعن توقعاته بقدوم الرجل الذي سيأتي ليحققه.
ومع بداية الألفية الميلادية الثالثة كان ذلك الرجل، باراك حسين أوباما، يصيغ الحلم ويُحوّلهُ إلى واقع خطوةً خطوة. كانت نظرته إلى المسافة بين الحلم والواقع في غاية الخصوصية. فرغم امتلاكه قناعةً داخليةً كبيرة بأنه سيصل إلى الحلم، كان يعلم بالمقابل أن تحقيقه يتطلب جهداً جباراً وتفكيراً مغايراً للمألوف.
صقلَ الرجل مهارته التنظيمية والإدارية من خلال العمل في مجالات متنوعة، من أكبر شركات المحاماة حيث خالط الأثرياء والبيض وكبار القوم، إلى أحياء شيكاغو الفقيرة حيث عاش مع السود والفقراء وأبناء الأقليات. قرأ المحامي المثقف التاريخ قراءةً استراتيجية، وأدرك أن بذور التغيير في الواقع باتت موجودة.
عرف أنه سيكون شخصياً التعبير عن الحلم بالنسبة للسود والأقليات الأخرى، لكنه عرف أيضاً أن تقديم نفسه كمرشح أقليات هو الطريق للفشل في بلدٍ مثل أميركا، فأصرّ على مخاطبة البيض لأنه كان يعلم أيضاً أنهم يبحثون عن حلمٍ جديد غير مألوف، وأن عليه أن يقنعهم بأنه يمثّل ذلك الحلم. لكن مفرق الطريق كان يتمثل في القدرة على فهم المنظومة المعقّدة، وعلى امتلاك قدرةٍ متميزةٍ في التعامل معها سياسياً وتنظيمياً وإعلامياً. ولم ينسَ أهمية الجاذبية والكاريزما الشخصية في ثقافة مجتمعه، فتدرّب وهو يتعامل مع الجماهير على تطوير مواهبه في الخطابة والتواصل والإقناع. وأصبح ماهراً في قراءة الواقع والتعامل معه بحيث يكون الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.
وحين جاء موسم الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2008 وظهر أوباما في الساحة، أصبح الحلم ظاهرةً عالمية. وبالتالي، كان فوزه بالرئاسة، في تلك اللحظة من عمر أميركا والبشرية، أمراً أشبه بالحتمية التاريخية.
لكن التاريخ نفسه كان حاملاً بتوءمين، ستكون ولادتهما مع بدايات وجوده في البيت الأبيض، التحدي الأكبر الذي واجهه الرجل.
فمن ناحية، وبعد أكثر من قرنين من عمر البشرية، بدأ يظهر أن الأنظمة، السياسية والاقتصادية، التي ركّبتها مفاهيم الليبرالية والحداثة مع عصر التنوير في القرن الثامن عشر تتعرض لهزاتٍ عنيفة عالمياً. كُتب، ولايزال يُكتب عن هذا الكثير، وتحديداً في أوروبا وأميركا، وقد يكون مثالاً يُعبّرُ عنها مقالٌ كتبه الباحث في معهد بروكينغز شادي حميد، في مجلة السياسة الخارجية (Foreign Policy)، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً، وبعنوان "نهايةُ نهايةِ التاريخ، دونالد ترامب يُعيد السياسة الأميركية إلى أصلها: صراعٌ على الهوية والأخلاق والدين"، نعود للتعليق عليه أدناه.

ترامب في حفل أداء قَسم الرئاسة
ومن ناحيةٍ أخرى، ظهر إلى الوجود "الربيع العربي"، وما حمله معه من انكشاف فقدان القدرة أو الإرادة، أو كليهما، على التعامل معه من قبل الغرب، وأميركا أوباما تحديداً، بما ينسجم مع قيمه النظرية. فضلاً عما خلقه الربيع المذكور، تدريجياً، من وقائع وظروف ساهمت في تأجيج الفوضى في العالم، مع انتشار ظاهرتي اللجوء والإرهاب بشكلٍ غير مسبوق. وهو العنصر الذي ضخ كثيراً من الحيوية في صعود الشعبوية والفاشية والعنصرية والسياسات اليمينية المتطرفة، في أوروبا وأميركا على وجه الخصوص.
هكذا، وجدت أميركا أوباما نفسها في قلب ما يبدو دورةً حضاريةً بشرية جديدة لم يكن ممكناً معها، رغم ثقافة الرجل وأفكاره التقدمية، إدارةُ شؤون العالم. تمثل البديل الوحيد المتوفر في ممارسة درجةٍ من الحياد السلبي في السياسة الخارجية بشكلٍ عام، مع تحييد اللاعبين الخارجيين من مثيري المشاكل، مثل إيران، ثم الانكفاء على الداخل الأميركي، ومحاولة "وضع، وصياغة، وتنفيذ، قوانين عدل ومساواة، وتشريعات وأنظمة... حسبما تقتضيه الضرورة والمصلحة. خدمة للخير العام في المستعمرة"، تماماً كما ورد في ميثاق "مي فلاور".
بالمحصلة، بدت أميركا، برئيسها وسياساتها، باهتةً في عين أهلها وعيون العالم من حولها منذ عام 2010. ورغم استفادة ملايين الأميركان من جهود أوباما في مجال التأمين الصحي وتخفيف نسبة العاطلين عن العمل، تعامل هؤلاء مع ماراه الرجل "إنجازات" على أنها مجرد حقوق طبيعية مأخوذة على سبيل التسليم، أو كما يقولون في أميركا: taken for granted.
والحقيقة أن حقبة أوباما بثت شعوراً بين التيار العام من المواطنين في أميركا، والليبراليين منهم تحديداً، بأن المكاسب التي سادت مع حقبة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، والمذكورة أعلاه، تجذرت في الثقافة الأميركية وصار من المستحيل اقتلاعها منها، ما دفع شرائح كبيرة من الأميركان إلى الاسترخاء.
وكما قال المخرج السينمائي والناشط التقدمي، مايكل مور، في مقال له عن أسباب توقعه لفوز ترامب بالرئاسة بعد ترشيحه رسمياً من قبل الحزب الجمهوري: "لقد فاز اليسار بالحرب الثقافية، يمكن للمثليين والسحاقيات أن يتزوجوا. تتخذ أغلبية من الأمريكيين الآن الموقف الليبرالي في كل سؤال تقريباً يطرح عليهم باستطلاعات الرأي: أجرٌ متساوٍ للنساء – نعم. يجب أن يصبح الإجهاض قانونياً – نعم، قوانين بيئية أقوى – نعم، سيطرةٌ أكبر على الأسلحة – نعم، تقنين الماريجوانا – نعم. لقد حدث تغيرٌ كبير – فقط اسأل الاشتراكي الذي فاز في 22 ولاية هذا العام، وليس هناك شك في رأيي بأنه إذا كان الناس يستطيعون التصويت من أريكتهم بالمنزل على أجهزة الإكس بوكس والبلاي ستيشن الخاصة بهم فإن هيلاري سوف تفوز بفارقٍ كبير".
تحدث مور عن تأثير الوضع الاقتصادي الذي لايزال سيئاً في ولايات "حزام الصدأ"، وعن افتقاد هيلاري كلينتون للشعبية والكاريزما، وعن الناخبين المُحبَطين للمرشح الديمقراطي السابق، بيرني ساندرز، كأسباب لتوقعه، وقتَها، فوز ترامب بالرئاسة. لكن أهم ما ذكره يتعلق بما أسماه "الفرصة الأخيرة للرجل الأبيض الغاضب" من ناحية، ولنوعٍ آخر من الغضب تشعر به شرائح متنوعة أخرى من الشعب الأميركي، وخاصةً الشباب، تجاه النظام السياسي الذي ينظرون إليه على أنه "معطوب" و"سقيم"، حسب توصيفه.
من هنا، يمكن التقاط الخيط الذي يربط السياسة بالثقافة في أميركا، ويُعين، بالتالي، على فهم ظاهرة وصول شخصٍ مثل دونالد ترامب إلى كرسي الرئاسة في البيت الأبيض. ففي حين جاء غضب الرجل الأبيض نوعاً من رد الفعل على المكاسب المُشار إليها قبل قليل، تراكم الغضب لدى آخرين لأنهم اعتبروها مجرد تطورٍ طبيعي، ومتأخر، وغير كافٍ، يُعبّر عما كان يجب أن يحصلَ في أميركا، إن لم يكن بعد كتابة ميثاق "مي فلاور" قبل أربعة قرون، فعلى الأقل بعد الاستقلال ووضع الدستور الأميركي، وليس بعد أكثر من قرنين على تلك الأيام.
هكذا، دار التاريخ دورةً كاملة. عاد الانقسام بين مواطني أميركا في درجات تركيزهم على القيم والعبارات المفتاحية الواردة في تلك الميثاق، وفي الدستور الأميركي وتعديلاته الشهيرة بعدها. ومعه، عاد الالتباس الذي يصاحب تجربة أميركا الضخمة والمعقدة، والذي كان ولايزال مصدر الأسئلة الكبرى والتحديات التي تواجهها.
في هذا السياق نفهم كلام شادي حميد في مقاله الذي أشرنا إليه سابقاً عن "نهاية نهاية التاريخ"، حين يقول: "مع ملاحظتي لانتشار التوجهات المعادية لليبرالية في كل مكانٍ تقريباً، من أوروبا إلى الشرق الأوسط إلى آسيا، إلا أنني كنت أرفض استنتاجاتي هذه حينما يتعلق الأمر بأميركا، وكنت أقاوم فكرة أن معاداة ترامب لليبرالية تروق للشعب الأميركي... [ولكن] ربما تكون هناك طريقةً أكثر تفاؤلاً للنظر إلى فوز ترامب بالانتخابات: ففوزه من الممكن أن يكون بمثابة التوبيخ الشديد لما أصبحت عليه الديمقراطية الليبرالية، شكلاً من التكنوقراطية الإدارية اليسارية المعتدلة التي تفتقر إلى الإلهام والقوة، على خلاف ما أراد لها مؤسسوها".
ومع الأخذ بعين الاعتبار أن تفسير الظاهرة يتضمن أيضاً رفض أنصار الليبرالية أنفسهم لما آلت إليه الليبرالية عملياً، إلا أن معاداة الليبرالية، وصعود اليمين المتطرف والعنصرية، باتت جميعاً تجد تجلياً عملياً لها في تزايد قبول الساسة الشعبويين وما يطرحونه من سياسات شعبوية.
يجب التفريق، هنا، بين سياسات اليمين المحافظ التقليدية وساسته التقليديين، وبين "اختطاف" القادة الشعبويين، من بوتين إلى ترامب، مروراً بماري لوبن وفروك بيتري وغيرت هولدر في أوروبا، لسردية اليمين المحافظ وقضاياه، وأحياناً لألفاظه ومصطلحاته. تُمكن الاستعانة هنا مرةً أخرى بطرح شادي حميد مثالاً، فهو يقول: "سواء في حالة العصبية لأجل مصالح السكان البيض في أميركا، أو حالة القومية العرقية في أوروبا، أو حالة الإسلاموية في الشرق الأوسط، فإن الخيط الذي يجمع كل هذه التجارب المختلفة واحد: السعي الشرس نحو سياساتٍ لها معنى يتجاوز فكرة المصلحة الفردية وجودة المعيشة. ربما تبدو هذه الأيديولوجيات فارغة أو غير مترابطة، ولكنها جميعاً تطمح إلى نوعٍ من التماسك الاجتماعي، وترسيخ الحياة العامة من خلال هوياتٍ محددة بدقة... جوهر السياسة إذاً في هذه الحالة لم يعُد متعلقاً فقط بتحسين جودة حياة المواطنين، ولكنه يصبح في المقام الأول توجيه طاقات المواطنين لغاياتٍ أخلاقية أو فلسفية أو أيديولوجية".
وفي حين يبدو التوصيف المذكور أعلاه للحالة منطقياً، إلا أن المفارقة ذات المعنى الكبير، التي لا يتحدث عنها الكاتب، تكمن في أن سيرة الرئيس الأمريكي المُنتخب لا توحي، من قريبٍ أو بعيد، بأنه يصدرُ في تفكيره وقراراته عن منطلقات تتعلق بالدين والأخلاق والهوية، ومن المؤكد أنه لم يفكر في أن تكون السياسة مصدراً لتوجيه طاقات المواطنين لغاياتٍ فلسفية. لكن فوزهُ، وتحديداً بتلك الصفات، يُظهر القوة الهائلة الكامنة في سياسات الهوية والمعنى، لأنه (استخدمها) فقط، وبشكلٍ أدواتي بحت، أوصله إلى البيت الأبيض بنوعٍ من (البساطة المُخيفة).
لهذا، أمكن لترامب الذي غيَّرَ انتماءه الحزبي خمس مرات على الأقل خلال ثلاثة عقود، والذي انسحب من الحزب الجمهوري آخر مرة عام 2011، أن يعود فيسجل نفسه جمهورياً، ثم يهزم 16 مرشحاً محافظاً جمهورياً في الانتخابات التمهيدية، ويفوز بترشيح الحزب عام 2016. وجاء هذا الانتصار لأن في الرجل، بالتأكيد، ما يشبه أميركا وثقافتها، كما كان في أوباما ما يشبه أميركا وثقافتها. فكما عبّرَ أوباما عن أميركا التقدمية والمثقفة، وأحياناً، المترددة والمنكفئة للعزلة في وجود مشاكل عالمية، يُعبّر ترامب عن أميركا الاستعراض والانا العالية، وأحياناً، البراغماتية بشكلٍ متطرف، والمُحِبَّة للإثارة، وللتجربة والتغيير بدرجةٍ عالية من المُخاطرة.
وحين يضع ترامب شعار حملته الانتخابية "جَعلُ أميركا عظيمةً مرةً أخرى"، ويكرر هذه المقولة في كل مناسبة بعد تنصيبه، ويُصدر كل تلك الأوامر التنفيذية، ويوزع المناصب كما باتَ معروفاً، فإن هذا يُذكّر بما اتفق عليه الموقعون على ميثاق "مي فلاور" فيما يتعلق بـ "وضع، وصياغة، وتنفيذ، قوانين عدل ومساواة، وتشريعات وأنظمة ودساتير ومناصب، من وقتٍ إلى آخر، حسبما تقتضيه الضرورة والمصلحة. خدمة للخير العام في المستعمرة". وإن حصل هذا، مرةً أخرى، بتفسيره الخاص لهذه المسائل.
استوعبت "المؤسسة" ترامب وسياساته بشكلٍ أو بآخر حتى الآن، لكن ما يمكن أن نسميه "المنظومة"، وهي تتضمن الإرث القانوني والأخلاقي والثقافي والاجتماعي لأميركا، وتغلبُ عليها صفة "التقدمية"، لا تبدو حتى الآن قادرةً على هضمه واستيعابه. من هنا بالذات كانت الهبة الجماهيرية التي انطلقت ثم انتشرت في أنحاء أميركا في اليوم التالي للتنصيب، وجاءت بمثابة صحوةٍ مفاجئة لكل القوى الليبرالية والتقدمية واليسارية على أمرٍ واقعٍ جديد لم يخطر لهم ظهورهُ على بال.
واليوم، يبدو مستقبلُ أميركا، ومعها العالم بشكلٍ أو بآخر، رهيناً بعملية الجدل والمدافعة بين كلٍ من "المؤسسة" بقوانينها الصارمة المتمحورة حول "المصلحة" الخاصة والعامة، بتعريفها، من جهة، وبين "المنظومة"، من جهةٍ أخرى، بكل ما خلقه تاريخ أميركا ودستورها ونضال الأعراق والإثنيات فيها من تقاليد وأعراف تقدمية، هي أكثرُ انسجاماً مع المشترك الإنساني العام، وأكثر قدرةً على أن يسير الإنسان في كل مكان، وفق هديها، إلى واقعٍ أفضل.
تحميل المادة بصيغة PDF:
- أميركا الماضي والحاضر: فصامُ شخصية أم التباسٌ ثقافي تاريخي؟ (1373 تنزيلات)

د. وائل مرزا
رئيس التحرير والمشرف العام على موقع معهد العالم للدراسات.
مواد أخرى لـ د. وائل مرزا
تعليقات
اترك تعليق*
* إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية:
- لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية.
- التعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها.
- يرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.


