حوار مع البروفيسور وائل حلاق حول الشريعة والإسلامويّة والدّولة العلمانيّة الحديثة (1 من 2)
مقدّمة المحاور
لا شكّ أنّ الدكتور حلاق مبرّزٌ بما يكفي لعدم تقدمته. ولكن، كما تجري العادة، فإنّه لا بدّ من تعريفٍ ما. يعمل الدكتور حلاق على مواضيع الشريعة والفقه الإسلاميّ وتاريخهما منذ ما يقارب الثلاثة عقود من الزمان. وقد صدرت له إنتاجاتٌ جمّة، تُعدّ بمثابة أعمال جوهريّة لأيّ دارس للشريعة وتاريخها، وهي، بلا شكّ، تشكل تحدٍّياً كبيراً أمام تيّار استشراقيّ غربيّ واسع.
يأتي هذا الحوار الذي قمت به مع الدكتور حلاق شاملاً النقاش الذي أعقب نشر كتابه الدّولة المستحيلة، والذي كُتبَ فيه الكثير. وقد شرّفني الأستاذ حلّاق بشرف الإجابة المستقصية، وهو العقل - الشخص واسع الصّدر والمعرفة والأخلاق قبل كلّ شيء. سيتم نشر الحوار في جزئين، يمثّل هذا الجزءَ الأول منه.
كانت أجوبة الأستاذ حلّاق بالإنجليزيّة، لذا اضطلعت بترجمته على نحو يجعله كأنّه حوار متسلسل لا ترجمة فيه. ولكن لا مهرب من الترجمة. أليسَ الفكرُ ترجمةً أصلاً، كما علّمنا هيدغر؟
ليست مهمة هذا الحوار أن يتعسّفَ في إثبات صوابية مقولات الأستاذ حلاق، فهذا يعود لمضمون الأفكار من ناحية، ولفهم القارئ من ناحية ثانية. وهو نفسهُ الذي يتحدث من بداية الحوار عن أن ما يُهمّهُ يكمن في "مركزيّة الأسئلة التي يثيرها الكتاب، سواء أكانت حججي مقبولة أم غير مقبولة، وبأنّ الإشكالات التي يطرحها الكتاب تكمن في لبّ الاهتمامات العربيّة والإسلاميّة"، كما يقول. أملي في نهاية المطاف، أنّ هذا الحوار يضيف، في عمقه ورصانته، آفاقاً للنظر تعضدُ ما في كتب الدّكتور حلاق نفسه من مقولات هامة.

السؤال الأول: ربّما لم يُثر كتاب ضجّة في الساحة العربيّة بعد ما يُسمّى الرّبيع العربيّ مثلما أثار كتابك الذي حملَ عنوانًا لافتًا هو "الدّولة المستحيلة". لقد نقده أقوام، وفرح به آخرون؛ فاعتبره صنفٌ إجهاضاً معرفياً لمشروع الإسلام السياسيّ الذي يحمل لافتة ديمقراطيّة وسط هذا الضباب الاستبداديّ والسّلطويّ الذي يخيّم على المنطقة بأكملها؛ في حين اعتبره صنف آخر تَصفية حقيقيّة لأوهام الإسلامويّة، وبالتالي إثباتًا للفكرة العلمانيّة الرائجة منذ مطلع القرن العشرين (علي عبد الرازق نموذجًا في الإسلام وأصول الحكم) التي تقول إنّ الإسلام لم ينطوِ على نمط حاكميّة سياسيّة. قد تكون، كأكاديميّ مرموق، مزعوجاً من هذه القِسمة الثنائيّة، لكن هذا هو الواقع فعلاً. ونعلم جميعاً أنّ الدّولة المستحيلة لم يُخاطب العرب والمسلمين أولاً، بل الغربيين بالإساس لإثبات عجزهم عن التعاطي الأخلاقيّ الجادّ مع نظرائهم المفكرين المسلمين. لكن اسمح لي، بما أنّ هذا الحوار موجَّه لقرائك العرب خصّيصاً، أن تشرح لنا ما أردتَ قوله بالضبط للعرب والمسلمين في هذا الظّرف الخانق الذي يعيشونه، وفي هذا المأزق التاريخيّ حقيقةً، بعد انسداد كلّ الآفاق المعرفيّة والسياسيّة في أغلب بلدانهم؟
وائل حلّاق: كما يعرف كلّ أحد، فإنّ المؤلف يفقد السيطرة على كتاباته وأفكاره في اللحظة التي تصبح فيها هذه الكتابات والأفكار منشورة على الملأ. ولا يمكنني أن أخبركم كم أذهلتني ردود الفعل المختلفة على الكتاب. لقد عرفتُ من قبل حتى اكتمال المسودّة الأولى أنّ الكتاب سيكون مثيراً واستفزازيّاً من الناحية الفكريّة، لكنّ الكتاب أثبت أنّه يتخطّى كونه استفزازيّاً بكثيرٍ بالنسبة إلى بعض القرّاء. وبالفعل، لقد تمّ تسييس الكتاب فيما وراء الاعتراف بقيمته وأهمّيته. بيد أنّني مرتاحٌ لفكرة أنّ كثافة ردود الفعل تتحدّث عن مركزيّة الأسئلة التي يثيرها الكتاب، سواء أكانت حججي مقبولة أم غير مقبولة، وبأنّ الإشكالات التي يطرحها الكتاب تكمن في لبّ الاهتمامات العربيّة والإسلاميّة.
لقد أساء كثيرٌ من القرّاء فهم الكتاب، يحدوهم طموح سياسيّ من بين أمورٍ أخرى في ذلك، ناسبينَ إلى الكتاب مواقف تتعارض مع أساسات تفكيري بحدّ ذاتها. على سبيل المثال، إنّني أختلف بعمقٍ مع الأطروحة الأساسيّة لعلي عبد الرازق حول الحوكمة الإسلاميّة السياسيّة. ومن ثمّ، ما مِن شيءٍ في كتاب الدّولة المُستحيلة يقرّ أفكار عبد الرازق ويصدّق عليها إذا ما قرئ الكتابُ بشكل صحيح. وإذ كانت الحكومةُ والسياسةُ (بالمعنى العامّ للمصطلحين) أدواتٍ لتنظيم المجتمع في بنيةٍ معقّدة، فقد قدّمَ الإسلام إذن، منذ بدايته، نهجاً متيناً للحوكمة، لكنّه نهجٌ أكثر مرونةً وتغيراً ممّا رأينا في العقدين أو العقود الثلاثة الأخيرة في الغرب (وفي جميع أنحاء العالم مؤخراً). كان عبد الرازق مخطئاً في حجاجه بأنّ الإسلام لم يقدّم نموذجاً للسياسة وللحوكمة. فقد قدّم الإسلام نموذجاً، ويمكن وصف النموذج بأنّه متطوّر جداً، وحتى أكثر تعقيداً في بنيته الداخليّة. بيد أنّ عبد الرّازق، مثله مثل المستشرقين، رأى غياباً في التنظيم القضائيّ والمؤسّساتيّ للإسلام، لأنّ اعترافاً بالنّظام المؤسّساتيّ والسياسيّ-القضائيّ المتين من شأنه أن يقف سدّاً في طريق "الإصلاح الحديث" الذي كان عبد الرّزاق وآخرون كثيرون غيره مندفعين في تبريره وتسويغه. وإذا تمّ الاعتراف بِنَسقٍ "جيّد التنظيم" كهذا بأنّه كان موجوداً على مدار التاريخ الإسلاميّ، فإنّ سؤالاً محرجاً وصعباً سيطرح نفسه: لماذا نختار النموذج المتمركز أوروبيّاً إذا كان التقليدُ الإسلاميُّ قد قدّم لنا نموذجاً كفؤاً بالمثل، حتى وإن لم يكن أكثر كفاءةً؟ حيث إنّ صيغة التبرير وتموقعها في أواخر اللحظة الكولونياليّة إنّما تحدّد من حيث الجوهر أفكار السّواد الأعظم من المفكّرين المسلمين، بمن فيهم أمثال عبد الرّازق. من ناحيةٍ أخرى، يرفض كتاب الدّولة المستحيلة شرعيّة ما يُسمّى بالإصلاحات ويعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من مشروع الكولونياليّة، بحيث يُحدّد بنيويّاً هذا المشروع، والذي ترك للمسلمين مفاهيم القوميّة والعقلانيّة المتأصّلة التي ضمنت استمراريّة الهيمنة الأوروبيّة، حتى بعد أن خرجت أوروبّا ماديّاً من كثير من الأراضي الإسلاميّة. وما نراه اليوم هو بقايا هذه الهيمنة.
ويتحتّم القول أيضاً إنّ أيّ حجّة مفادها أنّ كتاب الدّولة المستحيلة "يؤكّد" أفكاراً كأفكار عبد الرازق يجب أن تنظر إلى الكتاب باعتباره دفاعاً عن العلمانيّة، الأمر الذي يُعدّ قراءةً خاطئة تماماً. وليس سرّاً الآن أنّني معارضٌ أساساً للعلمانيّة، وللإنسانويّة العلمانيّة، وللعقلانيّة العلمانيّة ولكلّ منتجات عصر التنوير التي يمكن أن تكون مسؤولة عن المشاكل الكبرى في العالَم اليوم. وهذا ما أوضّحه بشيءٍ من التفصيل في كتابي القادم عن الاستشراق (٢٠١٨). وبالتالي، فإنّ الحجّة القائلة إنّ كتاب الدولة المستحيلة يناضل ضدّ المشروع الإسلاميّ من خلال نقدٍ علمانيّ هي حجّة سخيفة في أحسن أحوالها.
وأنتَ محقٌّ بقولك إنّ الكتاب كان موجّهاً بالأساس إلى الجمهور الناطق بالإنجليزيّة، لا سيّما إلى الأكاديميين والفلاسفة الغربيين، على الرّغم من أنّ الجماهير العربيّة والمسلمة لم تكن خارج نطاق الكتاب. إذا جاز التعبير، فإنّ الكتاب موجَّه إلى العالم، كما قد كتبتُ سابقاً (لا سيّما بعد ٢٠٠٥)، وذلك بحكم حقيقة أنّ كتبي ومقالاتي تترجم إلى كثيرٍ من اللغات. وهذه الحقيقة ماثلة في ذهني على الدّوام. وإنّه لصحيحٌ أنّ الكتاب، من حيث مضمونه وتداخلاته، كان رامياً أيضاً للاشتباك مع الفلاسفة الأخلاقيين والسياسيين الغربيين. ولم يلحظ الدّافع الأساسيّ وراء هذا الكتاب سوى القلّة القليلة من القرّاء في العالم العربيّ -على حدّ علمي-: أي إحضار منظورٍ إسلاميّ ورؤيةٍ للعالم وتجربة تاريخيّة على طاولة الأكاديميا الغربيّة، ولدفع الباحثين الغربيين، بطريقةٍ ما، إلى الاشتباك مع الإسلام وإيتيقاه وقيمه على قدم المساواة مع ما يُسمّونه بالإرث المسيحيّ-اليهوديّ، وهو الإرث الذي سيطر على النّقاشات لفترة طويلة جداً. فأنا مقتنعٌ، بعد أن درستُ التاريخ الإسلاميّ والتاريخ الأوروبيّ لعقودٍ، بأنّ كثيراً من التطوّرات الفكريّة الغربيّة على مدى آلاف السنين الماضية كانت متأثّرة بصورة كبيرة بالإسهامات الإسلاميّة في المعرفة والثقافة، وأنّ أوروبا استوعبت هذه المعرفة بطرق لا تُعدّ ولا تُحصى، وعلى مدار امتداد تاريخيّ طويل. لكن عندما يتحدث الأكاديميّون الغربيّون عن إرثهم الفكريّ والثقافيّ، فإنّهم يميلون إلى إزالة هذه العناصر من تراثهم الذي أسهم فيه الإسلامُ بصورة كبيرة للغاية.

هذا شِقٌّ من خلفيّة الكتاب. أمّا الشِّق الآخر، فيتعلّق بالإمكانات الكبرى للتقاليد الفكريّة الإسلاميّة للمساعدة في نقد الحداثة ولنقد كلّ آثارها السيّئة. وكما سبقَ وقلتُ في الصفحات الأولى من الكتاب، فإنّ التجربةَ الإسلاميّة بشكلٍ عامّ -بما فيها تجربتها السياسيّة والاجتماعيّة المُعاشَة- يمكن أن تقدّم أرضاً خصبة للنقد وللنقاش، وبمقدورها بهذا المعنى أن توفّر أراضٍ أكثر خصوبة ممّا قدّمه باحثون من أمثال ألسادير ماكنتير -أي من اشتباك ماكنتير مع أرسطو وتوما الأكويني. وليست المقارنات التي حاول عقدها كتابُ الدّولة المستحيلة مجرّد أفكار فلسفيّة، لكنّها أفكارٌ عِيشَتْ في واقع سياسيّ-اجتماعيّ حقيقيّ. باختصار، كان أحد الأهداف الأساسيّة للكتاب أن يسلّط الضوء على مشكلة الدّولة طويلة الأمد في المشروع الحديث ودعوة المفكّرين والأكاديميين الغربيين لإعادة التفكير في هذه المشكلة في ضوء التجارب التاريخيّة الأخرى. ذلكَ مشروعٌ استكشافيّ، وهو مشروعٌ جوهريّ للنقاشات الفكريّة. والتجربةُ الإسلاميّةُ، كونها أباً من أبويْ أوروبّا الحديثة، بمنتجاتها الفكريّة والثقافيّة، يمكن أن تقدّم زاداً وعتاداً كبيراً للتفكير بالطريقة التي يمكننا بها أن نعالج إمكانات الخروج من أزمات الحداثة.
ولكن لسوء الحظّ، في حين أنّ الغرب ينافح من أجل المواجهة وإيجاد الحلول للخروج من الأزمات الحديثة (التي أضحى معترفاً بها في الغرب الآن عموماً -وإنْ بشكلٍ غير كافٍ-)، فإنّ العالمين العربيّ والإسلاميّ يجعجعانِ بتقديم أنفسهما كحداثيين، وهذا ما يفعلونه بالمشي على خُطى الحداثة الغربيّة دون بذل أيّ قدر مهمّ من الفكر الاستقلاليّ والأصليّ. وإذا كان ثمّة شيءٌ تعلّمناه بشأن المشروع الحديث في العالم، فهو أنّ المشروع الحديث كان قصّة العالم غير الغربيّ الذي يحاول اللحاق بالغرب على نحو دائم: فكّلما قلَّدَ العالمُ غير الغربيّ الغربَ أكثر، كلّما تخلّف وراءَه، لأنّ التقليدَ دائماً وبحكم طبيعته يأتي متأخراً. ومع الوقت، يُجسّد العالمُ غير الغربيّ القيمَ والمؤسّساتِ الغربيّة، وبالفعل ينتقلُ الغرب إلى المرحلة الثانية. إنّ كتاب الدّولة المستحيلة أيضاً هو محاولة للتخلّي عن هذا الموقف، وهذا سبيلٌ من العيش والكينونة في العالم. فيشدّد الكتاب على أنّ النّقد الإسلاميّ لا يمكن أن يكون مستقلاً فحسب بل يمكن أن يقود الطريق أيضاً إلى ما يحاول الغرب تجاوزه تحت شعار ما بعد الحداثة. وبالتالي، فإنّ النقدَ الإسلاميّ (إذا كان للمرء شجاعة التفكير بطرقٍ جريئة) لديه القدرة على تقديم حلٍّ ما فوق حديث، أو عنده الاقتراح لحلّ ما، لا لمجرّد تصحيح الحداثة، وإنّما لإعادة هندستها من جديد بالأحرى -من خلال النّقاش العقلانيّ والمقاربة التدريجيّة. إنّه مشروعٌ بطيء وذو أناة، ولكنّه مشروعٌ يجب الاضطلاع والقيام به. وفي حال فشل تحقيق هذا الهدف الطموح، فإنّه مع ذلك يمكن أن يساهم في هذا الجهد، حتى ولو جزئيّاً، بدلاً من أن يظلّ متلقياً سالباً في عالم الإنتاج الفكريّ والثقافيّ.
وإذا تمّ القبول بذلك، فسيصبح إذن من الواضح لماذا يتوجّه الكتاب فوراً إلى كلّ من الجمهور الغربيّ والعربيّ/الإسلاميّ. ويتعيّن على الجمهور الأخير، من إخواننا وأخواتنا الذين يعانون عالماً مضطرباً، أن يدركوا النقاشات -في وسطهم وفي العالَم الغربيّ- من أجل البدء في رؤية قيمة إسهاماتهم في هذا المشروع العالميّ تفكيراً ونقداً. فلا يمكن أن يكون هناك نقدٌ إسلاميّ بدون استيعاب مشاكل الغرب -وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن يكون هناك استقلاليّة فكريّة دون الوقوف خارج البرديغمات [النماذج الفكريّة] الغربيّة المركزيّة.
السؤال الثاني: لعلّ بمقدورنا أن نقول إنّ اشتغالك الأخير، غير المفصول عمّا قبله طبعاً، هو إبستمولوجياً محاولة للاشتباك مع الفلسفة الأخلاقيّة، واجتهاد في استعادة الأخلاقيّ في شرطٍ أصبحت الأخلاق فيه ذرائعيّة. واهتمامك بمسألة المسؤوليّة الأخلاقيّة واضح، وهو برأيي اهتمام له شقّان لا أدري أتتفق معي في توصيفي لهما أم لا: شقّ معرفيّ بحت لمحاولة إيجاد بيئة أخلاقيّة جديدة بعد إرث عصر التنوير والكولونياليّة الغربيّة، وشقّ سياسيّ لمحاججة المفكّرين الغربيين الليبراليين الذين خدموا، بوعيٍ أو عن غير وعيٍ، السياسات الغربيّة تجاه الإسلام والمسلمين والمنطقة عموماً. وتعود أصولك إلى فلسطين، النّاصرة، البلد المحتلّ عن آخره. ماذا تفيد الأخلاق الآن؟ بمعنى آخر، ما الذي ستوفّره الدّعوة إلى فلسفة أخلاقيّة سياسياً بالمقام الأوّل ومعرفياً في هذا الشرط العالميّ الضاغط؟
وائل حلاق: هذا السؤال مهمّ بشكلٍ عميق. فقد يفسّر بعض القرّاء السؤال باعتباره يقيم تمييزاً ضمنيّاً بين الإيتيقيّ والأخلاقيّ من ناحية، وبين الإيتيقيّ والسياسيّ من ناحيةٍ أخرى. وإنّني لستُ متأكداً بالضبط ما هو قصدهم تحديداً. بيد أنّني يمكنني القول بثقةٍ إنّ مشروعي على مدى العقدين الماضيين كان منصّباً على التركيز على عدم فصل الإيتيقيّ عن أيّ مجال من مجالات الحياة، وهذا يعني أنّني أجدُ نفسي -لأنّ ذلك كان موقفي المُعتبَر- في خلافٍ مع أشكال العقلانيّة التي تقود ما سمّيتُه بالنّطاقات المركزيّة للحداثة ولعصر أنوارها. وأدركُ تماماً أنّ السياسة أكثر ملائمةً من حقول أخرى للنّشاط البشريّ لتوريط نفسها في الهيمنة والقوّة، وبالتالي لتوريط نفسها في السّلوك اللاأخلاقيّ والمعادي لما هو إنسانيّ. وعليه، فأنا لا أرتكزُ على السياسة لكبح السياسة، لأنّ فعل ذلك من شأنه أن يفتح الباب للإساءة والاضطهاد. إنّ فكرة فصل ما يُسمّى السّلطات الثلاثة بأكلمها (التشريعيّة، والقضائيّة، والتنفيذيّة) تسمحُ للسياسة تحديداً، بموجب تدبيرٍ معيّن، بالسيطرة على تعسّفها وتقليصه، وذلك هو السبب في أنّ النظام الحديث فشل كمشروع إنسانيّ وأخلاقيّ. وفي نهاية المطاف، فإنّ السّلطات الثلاثة هي جزءٌ لا يتجزأ من النظام برمّته. إذ تحتاجُ السياسة إلى شيءٍ ما آخر، شيءٍ يقف خارجها، من أجل التحكّم والانضباط، ولا يمكن لهذا الشيء أن يكون نظاماً من الضوابط والتوازنات التي يتمّ الإملاء بها من جانب إواليّة قسْريّة خارجيّاً، مفروضة على الذات من خارجٍ. لقد كانت خارجيّة القسْر هذه هي قصّة الحكم من قبل الدّولة الحديثة، وهي شكلٌ مختلٌّ من التشكّل الإيتيقيّ الذي يسمح، بقوّة، بإنتاج الطغاة والقتلة الجماعيين والأنظمة البيروقراطيّة التي لا تُعدّ ولا تُحصى. ويمكن أن يُرى فساد وتعسّف السّلطة (الذي يعمل عمله تحت محسّنات لفظيّة كثيرة) في كلّ مكان، وآخر طورٍ له يتجلّى أشدّ الجلاء في الموقف الراهن في الولايات المتحدة الأمريكيّة، حتى مع أقبح التمظهرات له في بلدان كثيرة، عربيّةٍ وغير عربيّة. ولا بدّ لي أن أوضّح أيضاً أنّني لا أرى كثيراً من الاختلافات بين المشاريع الكولونياليّة بوضوح والمشاريع السياسيّة الأخرى في الحداثة، اللهمّ إلّا كاختلافٍ في الدرجة. فمن حيث البنية الداخليّة، ليست الكولونياليّة الإسرائيليّة استثناءً عن حكم الدّولة الحديثة، وإنّما مجرّد درجة مكثّفة منه. ولكي نفهم إمكانات الدّولة الحديثة، يمكن للمرء أن يشخّص ملامحها في الحالة الإسرائيليّة بصورة أكثر يسراً من الحالات الأخرى، تماماً كما يتمّ تشخيص نموّ سرطانٍ بصورة أفضل في حالة متقدّمة. غير أنّ ذلك لا يعني أنّ بنية المرض غائب أو أقلّ إماتةً في حالة مبكّرة. فكما أشرحُ في كتابي القادم عن الاستشراق، فإنّ الدولة الحديثة مهيّأة بطبيعتها لمجموعة محدّدة من المواقف، بما فيها صلاحيّة اللاأنسنْة والقيام بإبادة جماعيّة شاملة. فكلّ دولة قادرة على الإبادة الجماعيّة بواقع كونها دولة (وبالطّبع ذلك جزءٌ من قصّة معقّدة أتناولها بالتفصيل في كتابي القادم آنف الذكر). لكنّ الدّولة مهيّأة أيضاً للقيام بأشياء كثيرة أخرى على نحو معيّن، بما فيها استعمال القانون لتحقيق الغايات الهدّامة، وتعزيز التعسّفات الاقتصاديّة والاستغلال الاجتماعيّ، وخلق المواطن العسكريّ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وبالتالي، فأنا لا أفصلُ بحالٍ بين الإبستمولوجيّ/الفكريّ والسياسيّ. وفي تجربتي الشخصيّة، كانت الكولونياليّة الإسرائيليّة الاستيطانيّة بالطّبع دافعاً كبيراً لبناء نقدي، لكن من المهمّ أن نفهم أنّه في حين أنّ التبدِّي الخارجيّ لهذا الموقف كان سياسيّاً، فإنّ جذوره وأساساته أكثر اتساعاً -وأكثر عمقاً- من ذلك. فليست إسرائيل وأشباهُها مشكلة سياسيّة فحسب. كما إنّه لا السياسة ولا السياسيّ (بالمعنى الشيميتّي) أفكار كونيّة سادت التاريخ البشريّ منذ عهدٍ سحيق: فهي بشكل كبير نتاجٌ لضربٍ معيّن من ضروب التشكّل الأخلاقيّ (الذي يجب أن نقول إنّه غير إخلاقيّ) الحديث. وما الدولة الحديثة، والكولونياليّة، والإبادة الجماعيّة، وخلافه، سوى نتاج وتمظهرات لهذا التشكّل.
إنّ استدعاء الأخلاقيّ هو دعوةٌ للوعي بتشكّل الذاتيّة البشريّة، ووعي بالدّور المحوريّ الذي يلعبه الفردُ، باعتباره أهلاً للمسؤوليّة الأخلاقيّة وللمساءلة. لقد تجاوزت المؤسّسة، في الحداثة، الفردَ عبر استعباد ذاتيّته/ا وفاعليّته/ا، وبالتالي سخَّرته لمقتضيات السّلطة المؤسّساتيّة. فليست مؤسّساتنا الحديثة مجرّد تقانات للتدبير والإدارة -إنّها، بالأحرى، بنى لأشكال بعنيها من العقلانيّة. وأعتقدُ أنّه آنَ الأوانُ للنّظر في إنتاج الذّات الفرديّة باعتباره الخطوة الأولى لأيّة مؤسّسة. ولا أظنّ أنّ هناك ما هو أهمّ من الشّروع في تشكيل نقدنا المتجاوز لما هو حداثيّ.
السؤال الثالث: يؤسس كتاب الدولة المستحيلة الالتزام على الأخلاق، حيث تقول فيه: "إن الأخلاقي هو نطاق الإسلام المركزيّ". يقوم اليقين و/أو الالتزام على سلطة الضمير كقاعدة للتحكّم في الذات، حيث لا يحتاج الضمير لموجّه، "فأنْ تمتلك ضميراً فذلك يكفي" كما يقول كانط. ويقول روسّو إنّ الالتزام الأخلاقيّ يقوم على سلطة الضمير الذي غرسه الله داخل الفرد من دون العودة إلى الغارس. وهذا ما يجعل طلال أسد يقول إنّنا عندما نجعل الضمير كقاعدة للتحكّم في الذات ألا يجعلنا ذلك أمام شيء حديث ومسيحيّ في الوقت نفسه؟ يعتبر الدولة المستحيلة أنّ أهم مبدأ أخلاقيّ "هو عدم القدرة على أو الامتناع عن ارتكاب عمل ما ليس لأنّك لا تستطيع فعله من حيث المبدأ، بل لأنك لا تستطيع العيش مع نتائجه". هنا تريد أستاذ حلاق تقييد الفعل لواجهة ما يمكن تسميته بـ"الإرادة الاقتحاميّة" (دمار الطبيعة، تفكيك بنى عضوية مثل الاسرة وغيرهما). هنا الأخلاقي يعني الامتناع عن الفعل، وهي فكرة نجدها عند طه عبد الرحمن الذي تُشيد به دائمًا. أصولياً، الأفعال لا تخرج عن: الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والمباح. فالواجب لا يمكن أن يقوم على الأخلاقيّ؛ لأنّه ليس نابعاً من الضمير، بل من سلطة النصّ كنصّ، بمعنى لا يمكن الامتناع عن فعله لأنّه يعاقب على تركه ببساطة. بينما يتجسّد الأخلاقيّ في المكروه لأنه متروك لضمير الفرد؛ فإنْ قام به فلا يعاقب وإنْ امتنع عن القيام به يُثاب حيث يوجد خيار الضمير هنا. وهذا أيضًا ينطبق على المندوب. ولا ينطبق على المحظور، فهذا يعاقب على فعله، ويثاب على تركه. وهكذا، ألا ترى أنّ قولك إنّ "الاخلاقيّ هو النطاق المركزيّ للإسلام" يجعل من أفعال التكليف كلّها متساوية أو على مرتبة واحدة؟
وائل حلّاق: أعتقدُ أنّ السبيل الأمثل للإجابة على سؤالك تتمثّل في التفرقة بين الضّمير وما أطلقَ عليه الغزاليُّ وفوكو برياضة النّفس وبتقانات الذات على التوالي. وبرأيي، لم يكن كانط مهتمّاً بهذه التقانات؛ وذلك لأنّه نظرَ إليها باعتبارها رواسب من إرثٍ مسيحيّ استبداديّ. اهتمّ كانط بشكلٍ مكثّف بالإرادة العقلانيّة الحرّة، وكانت "الحريّة" التي دعا إليها متناقضةً إلى حدّ كبير مع مفهوم تقانات الذّات، على الأقلّ بالطريقة التي فهمَها هو في ثوبها المسيحيّ. ولعلّ هذا ما أرادَ طلال أسد أن ينقدَه. فالضمير سبيلٌ مفتوحةٌ للعيش في العالم، وهي سبيلٌ يمكن تعريفها وإعادة تعريفها باستمرار في الإرادة: وهو الأمر الذي يفسّر رواجه في الخطاب والممارسة الليبراليّة. ولا يلتزمُ الضميرُ بالضرورة بإملاءات المبادئ الأولى، وهي تلك المبادئ التي تُعيّن حدّاً، أو ما أسّميه أنا بمرجعيّة، حول السّلوك البشريّ، سواء أكان هذا السّلوك اعتقاداً أو فعلاً. وكون الضمير مروَّضاً إيتيقيّاً -وأنا أستعملُ المصطلح الأخير بأناةٍ وحذر- فيعني أنّه يكون في العالَم بشرطٍ من الهابيتوس* الإيتيقيّ، وهو نمطٌ من التهذيب الإيتيقيّ للذّات الذي يمرّن الرّوح على الاشتباك مع العالم (بعناصره البشريّة، والحيوانيّة، واللامجسَّدة) بطريقةٍ مسؤولة؛ بيد أنّ الأكثر إثارةً من ذلك بشأن ذلك الهابيتوس هو حقيقة أنّ سيرورة الهابيتوس تصوغها وتشكّلها أفعالٌ محدّدة، نسقيّة ومنتظمة، تنتجُ ذاتيّةً محدّدة. وعليه؛ تلفّ المشاكل كثيراً من الليبراليّة وسبل العيش الليبراليّة: فالهبيتوس الليبراليّ مائعٌ وخاضعٌ لتغيُّرات المصالح الماديّة والرأسماليّة والاستهلاكيّة، والتي هي مُحدّدةٌ كلُّها، في نهاية المطاف، بمفهوم الحريّة السَّالِبة (التي ناصرها إزايا برلين ومن على شاكلته كما هو معلوم). ففي الليبراليّة، ليس ثمّة مرجعيّة إيتيقيّة تربطُ دائماً المعتقد والفعل البشريّيْن بالمبادئ الأولى -أي بما هو خلاف المفاهيم المعينة للملكيّة والماديّة والتدبير السياسيّ الخانع. ويجب علينا ألّا ننسى بأنّ هذه التدبيرات الأخيرة ليست مستقلّة، بل تنتجُ مباشرة عَقِب اقتصاديّات وعقب مفهوم محدّد جدّاً للملكيّة. ويمكننا أن نرى آثارَها هذه في بزوغ الشّركة الحديثة وآثارها المدمّرة بشدّة على المجتمع الحديث.
وبالتالي، عندما نتحدّث عن تقانات الذات باعتبارها متّصلة بتصوّر المبادئ الأولى، فإنّنا نتحدّث عن ذاتٍ ملتزمة بمبادئ أخلاقيّة ليس بإمكانها أن تفسّرها بمعزلٍ عن الإرادة. وبكلمات أخرى، عندما تختفي المبادئ الأولى من الحياة البشريّة، فإنّ السيادةَ تكفّ عن البقاء في أيّ شيء يسمو على الإرادة البشريّة، سواء أكان فرداً أو دولةً. بعبارةٍ أخرى، غالباً ما تحرمُ المبادئ الأولى المجتمع البشريّ من هذه السيادة، هذه السيادة التي أثبتَ وجودها القويّ في الحياة الحديثة كارثيّتها تماماً (كما وضّحت ذلك بإسهاب في كتابي عن الاستشراق).
بيد أنّ تقانات الذّات التي أتحدّث عنها هنا إنّما تقوم بما هو أكثر من مجرّد تخصيص السيادة بالمبادئ الأولى. إذ تخلقُ هذه السيادةُ، أو تستمرّ في خلْق، بنيةً من المواقف والمعتقدات تعملُ عملها دائماً على نحوٍ تتغلّل به في كلّ المواقف بواسطة قالبٍ إيتيقيّ أو ركيزة إيتيقيّة. ولا يعني ذلك، كما قد خَلُصَ كثيرٌ من قرّاء كتابي الدّولة المستحيلة بشكلٍ خاطئٍ، أنّ كلَّ شخصٍ أو مجتمعٍ ككلّ يُدبّر ذاته إمبريقيّاً بطريقةٍ إيتيقيّة. فتلكَ قراءةٌ سطحيّة وانتقائيّة لكتابي، وهي قراءة تبني القشّة بسهولة لجعل مهاجمة الكتاب أيسر لناقدٍ دوغمائيّ ومتهوّر. فعندما أتحدّث عن تقانات الذات، فليس لديّ في اعتباري فقط مفهوم للمعياريّة، وإنّما على وجه التخصيص، مفهوم للمرجعيّة. ولا تنجحُ المرجعيّات تماماً دائماً في تحقيق أمانيها في العالم الفعليّ، ولكن تقفُ بالأحرى كتذكيرٍ لا يتزعزع وكمعايير عنيدة لا يُقاس الواقع ضدّها فحسب، بل يُضغَط به ضدّها. والمرجعيّة الراسخة هي المرجعية التي يكون ضغطها أكثر بكثير من الضغوطات التي تقوم بها مرجعيات أُخَر، لا سيّما إذا كان قالبُ سلطتها ومصدرُها مشتّقاً ممّا أسميته في الكتاب بـ"النطاق المركزيّ". وإذا كانت المرجعيّات الإيتيقيّة بحكم التعريف أخلاقيّةً وإيتيقيّةً، فإنّ منهجَها إذاً هو أقلّ قسريّةً وأكثر تعليميّةً؛ وإنّها، لهذا السبب تحديداً، تسمحُ بمزيدٍ من الانحراف عن المعيار المفروض قسْراً.
ما أطمحُ بالتشديد عليه هو الآثار النَّسقيّة للمرجعيّات؛ بمعنى عملها على الرّوح، بغضّ النّظر عمّا إذا كانت هذه الرّوح الفرديّة ملتزمة بهذه المرجعيّات أم لا. وإذا نُظر إليها على هذا النّحو، فإنّ هذه المقولات مثل "المحظور" و"الواجب" لا يمكن أن تُفصَل عن مقولات أخرى من حيث المحتوى الإيتيقيّ والعلاقة الإيتيقيّة بينهم. لقد شُكِّلتِ الرّوح بتقاناتٍ (وقد تأخذ هذه التقانات أيّ صيغة أو أيّ شكل، وما فقه العبادات أو التعاليم والممارسات الصوفيّة سوى تشكّلين قائمين من بين تشكّلات أخرى) -كما أتحدّث عنها- ليس بمقدورها التمييز، مثلاً، بين "المستحبّ" عن "المحظور"، لأنّ كلّاً منهما أعمال طاعة وتعبُّدٍ نابعة من الذّات الإيتيقيّة نفسها. ومع ذلك، يجب ألّا يعني ذلك أنّ كلّ الأفعال متساوية، لأنّ الأفعال باعتبارها مقولاتٍ فقهيّة-أخلاقيّة خطابيّة قد تكون تراتبيّة، أو ثانويّة، أو غير ذلك. فمن الواضح مثلاً أنّ القتل ليس هو نفسه بمرتبة عبور الشارع والضوء أحمر. كما إنّه ليس "المحظور" مساوياً لـ"المستحبّ". لكنّ هذا ليس موضوع حديثنا. ما هو على المحكّ في إشكاليّتنا هو كيف تعمل المرجعيّة الإيتيقيّة وتقانات الذّات معاً لإنتاج الذات المروَّضَة إيتيقيّاً بقدر ما يرى/ترى الواقع ويتعامل/تتعامل معه، بما في ذلك تشكيلة الأفعال المتاحة له أو لها. فإذا كنتُ ذاتاً تمّ تشكيلها إيتيقيّاً، فإنّ ملكاتي الإيتيقيّة ستتخلّل أيّاً ما أقوم به وتدخل على كلّ أفعالي، سواء أكان عبورَ شارع أو دفعاً لـ"ضرائبي"، أو، إذا كنتُ جنرالاً عسكريّاً، عندما آمرُ بعمل إبادة جماعيّة ضدّ جماعة أخرى. فلا يمكنُ للذات الأخلاقيّة الحقّة أن تكون متشظيّة ولا قابلةً للقسمة.
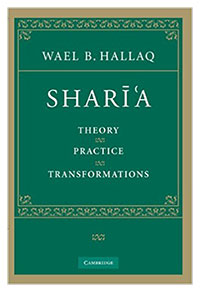
السؤال الرّابع: إذا عدنا قليلًا لأعمالك السابقة، لا سيّما "هل يمكن استعادة الشريعة؟" (٢٠٠٤) ثمّ كتابك الكبير الشريعة: النظريّة والممارسة والتحوّلات (٢٠٠٩)، سنجد فكرة مفادها أنّ "الشريعة" كما نفهما اليوم كنسق قانونيّ هي فكرة حديثة جداً، وعلمانيّة بالأحرى، فتقنيين الشريعة هو الصيغة الأكثر تدميراً للشريعة في واقع الأمر، وهو أمر ساعد عليه الاستشراق عندما فهمَ الشريعة باعبتاره "Law"، وأيضاً عندما اختُزلت الشريعة في المستعمرات إلى قانون الأسرة والأحوال الشخصيّة. لا شكّ أنّ هذا الاختزال، كما تشير صبا محمود في الاختلاف الدينيّ في عصر علمانيّ وحسين عجرمة في مساءلة العلمانيّة، كان على صلةٍ وثقى بمشروع الدّولة الحديثة للتصرّف في الشريعة وجعلها تحت إمرتها. فهل شارك الإسلاميّون في هذا المنعطف بدعوتهم لـ"تطبيق الشريعة"؟
وائل حلّاق: أودّ، أوّل الأمر، أن أفصل المقالة عن الكتاب. فقد عُدِّلت مقالتي "هل يمكن استعادة الشريعة؟" من جانب كتاباتي اللاحقة، وأعتبر أنّ هذه المقالة مضى عليها الزمن (كما أشرتُ في الدّولة المستحيلة). لذا؛ فهي ليست ذات صلةٍ بأيٍّ من اهتماماتي الراهنة.
أعتقدُ أنّه من المعلوم على نحوٍ واسع اليوم أنّ الشريعة بعد عام ١٨٢٦ لم تعد مثل سالفتِها، اللهمّ إلّا في الاسم فحسب. وكتابي الشّريعة، المنشور عام ٢٠٠٩ هو، بمعنى ما، بيانٌ شاملٌ عن هذا التاريخ. فمن المستحيل أنْ نفهمَ التاريخ ما بعد ١٨٢٦ (وقبله في الهند بقليلٍ) دون إدراك الوجود التامّ للدّولة الحديثة وسلطتها. تكمنُ المشكلة ههنا في أنّ هذه الدّولة، لكونها قويّة وهيمنيّة، غدت مُسْتبْدَهةً ومسلَّماً بها، وحدسي هو أنّ عدداً قليلاً جدّاً اليوم مَن يتصوّر العالَم دون دولةٍ. إذاً، من المفهوم أنّه عندما يهاجمُ بعضُ النّقاد كتابي الدّولة المستحيلة بشراسةٍ لا تلين، فإنّهم إنّما قاموا بذلك لأنّهم ليس بمقدورهم أن يتخيّلوا العالَم دون هذه الدّولة. إذ إنّ الدّولة الحديثة هي -مع الأسف- الحدّ الناظِم لتفكيرهم بصورة قويّة. وأؤمنُ أيضاً أنّ الإسلامويين لم يشرعوا حتّى في التفكير في أشكال مغايرة للحوكمة. فالمشكلةُ، كما أراها، هي أنّ الإسلامويين (بكلّ اختلافاتهم وتنوعاتهم) لا يفهمون ما هي الدّولة الحديثة باعتبارها شكلاً محدّداً من الحوكمة والحكم. وليس الليبراليّون العلمانويّون في العالم الإسلاميّ بأفضل حالاً. يظنّ الإسلامويّون أنّهم حالما يمكن تطبيق نسخة وضعيّة من الشّريعة، فإنّهم سيحقّقون الدّولة الإسلاميّة تلقائيّاً. وهذا خطرٌ كبير يفضحُ الفهمَ المبتذَل لما هي عليه الدّولة حقّاً في الواقع. وعليه؛ فنَعمٌ: الإصرارُ، في آنٍ واحدٍ، على الدّولة الحديثة وعلى تطبيق الشّريعة في ظلّ حكمها سيكونُ إخضاعاً للشّريعة لنظامٍ سياسيّ أعلى، وهو نظامٌ يتعارضُ مع أيّ مفهومٍ للشّريعة -كما عرفناها على مدى اثني عشر قرناً قبل الكولونياليّة-. وإذا كان على الدّولة أن تحدّد محتوى الشريعة واختصاصها، فإذن هذه الشريعة هي قانونُ للدّولة ولا يمكن أن تكون أيّ شيءٍ آخر. وعندما تُملي الفاعليّة التشريعيّة المستقلّة للشريعة على [السّلطة] التنفيذيّة ما بإمكانها أن تفعله وما ليس بإمكانها فعله، فعندها فقط يمكننا أن نبدأ -فقط نبدأ وليس أكثر- في القبض على أساسيّات حوكمة الشّريعة. والحال أنّ هذه الصورة الأخيرة -كما أوضحتُ في الفصل الثالث من الدّولة المستحيلة- متناقضةٌ كليّاً مع الدّولة الحديثة، وليس بوسع أحدٍ من النّاس، إلّا المكابر، أن ينكرَ ذلك.
ولا أظّنه من قبيل المبالغةِ القولُ إنّ الإسلامويين يواجهون تحدّييْن على أقلّ تقدير -وهما التحدّيان اللذان دفعهما كتابُ الدّولة المستحيلة بقوّة إلى المواجهة. التحدّي الأول هو أنّهم ، وقبل الشّروع في أيّ طموحٍ سياسيّ، يحتاجون إلى فهم المبادئ التي حكمت عمل الشّريعة على مدار التاريخ، وذلك حتّى القرن التاسع عشر. فلا يزال هذا الفهم منعدماً، وإنْ كان ثمّة فهم، فيبقى متورّطاً بمفارقاتٍ والتباساتٍ تاريخيّة على أقلّ تقدير. لستُ أقول إنّ الأنماط التاريخيّة الفعليّة لعمل الشّريعة ومؤسّساتها التاريخيّة يمكن بعثها من جديدٍ في عالمٍ اليوم كما كانت موجودةً في الماضي. فهذا أمرٌ مستحيل، كما يجب أن يقرّ أيّ إنسان عاقل بذلك. بيد أنّه من المهمّ أنْ نفهم المبادئ التي حكمت عملَ الشريعة، سواء في العالَم الطبيعيّ أو في التدبير السياسيّ؛ إذ إنّ تلك المبادئ تختلفُ اختلافاً بيّناً عن تلك المبادئ التي توفّرها الدولة الحديثة. ويجب عليّ تبيان أنّه ليست هذه المبادئ مهمّة بسبب هذا الاختلاف فحسب. فهي مهمّة، إذا فُهِمَت بشكلٍ سليم، بسبب كونها تقدّم سبيلاً للمضيّ قدماً؛ لأنّه تكمن فيها بذرةٌ لنقد هادفٍ وذي معنى. فليس النّموذج الماديسونيّ (Madisonian model) الذي تبنّته أوروبا وأمريكا صالحاً لكلّ الشعوب ولكلّ المجتمعات في العالم. حيث إنّ تلك النماذج انبثقت من سيرورة تاريخيّة محدّدة لم تجترحها المجتمعات المسلمة، وذلك لأنّ تاريخهم وشريعتهم عملا عن طريق منطقٍ مختلف.
ثانياً، يحتاجُ الإسلامويّون إلى دراسة الدّولة الحديثة، والتي لم تُفهَم إلّا قليلاً حتى في الغرب. فلم يشرع الإسلامويّون حتى في فهم هذه الظاهرة الكبرى والهامّة جداً. كيف يمكننا أن نمضي وأن نرسمَ شكلاً من الحوكمة دون فهم المعطيات المتاحة لنا، في الواقع وفي الإمكان؟ وإذا بُعث فقيهٌ مسلم من القرن الثاني أو السادس أو العاشر من جديد، لكان له أن يقول على الأرجح إنّ باب الاجتهاد الإسلاميّ قد أُغلقَ تماماً في القرن العشرين والحادي والعشرين. إذ كلّ سيراه ليس سوى تقليد أعمى ميؤوسٍ منه للغرب لا أقلّ ولا أكثر!
ويتحتّم عليّ أن أضيف بأنّه يجب ألّأ نُغرَّ ببعض البرامج الفكريّة المؤثّرة التي تزعمُ أنّها تقدّم "مشاريعَ إصلاحيّة" مستقلّة عن حداثة الغرب. فهذه المشاريع -وأذكر ههنا أحد النماذج البارزة مثل مشروع محمّد عابد الجابريّ- ليست على بيّنةٍ بتواطؤها مع بنى الهيمنة لعصر الأنوار وحداثته. ولا تملك هذه المشاريع سوى مظهر خادعٍ من الاجتهاد، لكنّها، في جوهرها وفي لبّها الحقيقيّ، ليست بشيءٍ من هذا القبيل.
* رأيت إبقاء مفهوم الهابيتوس كما هو دونما تعريب. إذ كلّ المحاولات الترجميّة لها غير مقنعة، أو قاصرة في أحسن الأحوال. وعليه، فلمعرفة المفهوم عند بيير بورديو واستعمالاته السوسيولوجيّة والمعرفيّة، يمكن الرّجوع إلى هذه الدراسة التفصيليّة عن مفهوم "الهابيتوس" من ترجمة الصديق العزيز طارق عثمان، انظر الرابط. [كريم محمد]
 المؤلف: وائل حلاق
المؤلف: وائل حلاقأستاذ الشريعة في جامعة ماكغيل. وحالياً أستاذ في الدراسات الشرق أوسطية بجامعة كولومبيا. له إصدارات عدة، منها كتاب "الشريعة: النظرية والممارسة والتحولات"، و"الدولة المستحيلة"، إلى جانب ثلاثيته عن الفقه الإسلاميّ تاريخاً ونظريةً؛ غير العديد من الكتب والأوراق العلمية.
* انظر الجزء الثاني.
تحميل المادة بصيغة PDF:
- الرابط (1646 تنزيلات)

كريم محمد
باحث ومترجم مصري. مهتم بأسئلة الدين والعلمانيّة والسوسيولوجيا والفلسفة المعاصرة. وصدرت له في ذلك مقالات وأبحاث منشورة إلكترونيّاً. بالإضافة إلى أنه صدرت له ترجمة كتاب "الاختلاف الدينيّ في عصر علمانيّ" عن مركز نماء للأبحاث والدراسات.
اترك تعليق*
* إرسال التعليق يعني موافقة القارئ على شروط الاستخدام التالية:
- لهيئة التحرير الحق في اختصار التعليق أو عدم نشره، وهذا الشرط يسري بشكل خاص على التعليقات التي تتضمن إساءة إلى الأشخاص أو تعبيرات عنصرية أو التعليقات غير الموضوعية وتلك التي لا تتعلق بالموضوع المُعلق عليه أو تلك المكتوبة بلهجة عامية أو لغة أجنبية غير اللغة العربية.
- التعليقات المتكوبة بأسماء رمزية أو بأسماء غير حقيقية سوف لا يتم نشرها.
- يرجى عدم وضع أرقام هواتف لأن التعليقات ستكون متاحة على محرك البحث غوغل وغيره من محركات البحث.


